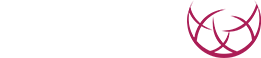الصوتيات
الصوتيات
- الصوتيات
- علماء ودعاة
- محاضرات مفرغة
- يوسف الغفيص
- شرح القواعد السبع من التدمرية
- شرح القواعد السبع من التدمرية [5]
-
الإثبات المفصل والنفي المجمل في باب الأسماء والصفات
الإثبات المفصل والنفي المجمل في باب الأسماء والصفات
قوله: (والله سبحانه وتعالى بعث رسله):
وهذا من فقه المصنف أنه عبر بكلمة (الرسل)؛ لأن دينهم وأصولهم واحدة.
وقوله: (بإثبات مفصل):
أي: بإثباتٍ لصفاته وأسمائه على التفصيل.
وقوله: (ونفي مجمل):
الكلام المجمل: هو الكلام الكلي الذي لا يفصَّل على معانٍ، وهذا مشهود معروف في عرف الناس وذوقهم وفقههم، وإن عبروا عنه من جهة اللسان أو المنطق أو غيرها بأسماء مختلفة.
وقول المصنف: (والله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل) لا يريد بذلك أنه لا يقع في القرآن إثبات مجمل ولا نفي مفصل، وإنما يريد هنا أن يبين أصل القاعدة عند أهل السنة المخالفة لقاعدة المخالفين لهم، وإلا فإنه قد جاء في القرآن إثبات مجمل في أسماء الله، كما في قوله تعالى: ![]() وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ![]() [الأعراف:180] فهذا إثبات مجمل، حيث لم تذكر الأسماء في هذا السياق، نحو: السميع، أو البصير، أو العزيز، أو ما إلى ذلك.
[الأعراف:180] فهذا إثبات مجمل، حيث لم تذكر الأسماء في هذا السياق، نحو: السميع، أو البصير، أو العزيز، أو ما إلى ذلك.
وقد جاء الإثبات المجمل في الصفات في القرآن كقوله تعالى: ![]() وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى ![]() [النحل:60] أي: الوصف الأعلى، فهذا مجمل، حيث لم يذكر الله في الآية صفة الرضا، أو المحبة، أو العلم، أو القدرة، أو ما إلى ذلك من الصفات، إنما قال:
[النحل:60] أي: الوصف الأعلى، فهذا مجمل، حيث لم يذكر الله في الآية صفة الرضا، أو المحبة، أو العلم، أو القدرة، أو ما إلى ذلك من الصفات، إنما قال: ![]() وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى ![]() [النحل:60]
[النحل:60]
ويأتي النفي مفصلاً في القرآن أحياناً؛ كقول الله تعالى: ![]() وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً
وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ![]() [الكهف:49] وكقوله تعالى:
[الكهف:49] وكقوله تعالى: ![]() لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ
لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ![]() [البقرة:255] فهذا نفي لصفة السِّنَة، وصفة النوم، وصفة الظلم، وهو نفي مفصل.
[البقرة:255] فهذا نفي لصفة السِّنَة، وصفة النوم، وصفة الظلم، وهو نفي مفصل.
إذاً: قول المصنف: (والله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل) هذا من حيث الأصل والقاعدة، فإن الغالب في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم هو ذكر التفصيل في مقام الإثبات، وذكر الإجمال في مقام النفي، وإلا فإن هذا يقع وهذا يقع، لكنه ليس هو الأصل.
النفي المفصل يتضمن الإثبات
قال المصنف رحمه الله: [ فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل ].
قوله: (من التشبيه والتمثيل) هذا جمع حسن.
قال المصنف رحمه الله: [ كما قال تعالى: ![]() فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً ![]() [مريم:65] قال أهل اللغة:
[مريم:65] قال أهل اللغة: ![]() هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً
هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً ![]() [مريم:65] أي: نظيراً يستحق مثل اسمه، ويقال: مسامياً يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس : هل تعلم له مِثْلاً أو شبيهاً ].
[مريم:65] أي: نظيراً يستحق مثل اسمه، ويقال: مسامياً يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس : هل تعلم له مِثْلاً أو شبيهاً ].
هذا معناه واحد، سواء قيل: ![]() هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً
هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً ![]() [مريم:65] أي: شبيهاً، أو مثيلاً، أو نظيراً، أو ما إلى ذلك.
[مريم:65] أي: شبيهاً، أو مثيلاً، أو نظيراً، أو ما إلى ذلك.
-
استخدام القرآن للأدلة العقلية لإبطال طرق المنحرفين
استخدام القرآن للأدلة العقلية لإبطال طرق المنحرفين
تأمل هذه الآيات تجد أن سياقها عقلي، يرد فيها الله سبحانه وتعالى ويبطل طرق المنحرفين عن الفطرة، وعن آثار الرسل ودينهم، في مثل قول الله تعالى: ![]() وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ![]() [الأنعام:100] أي: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، ومع ذلك جعلوا له هؤلاء الشركاء؛ ولذلك تجد في سياق الآيات كقوله تعالى:
[الأنعام:100] أي: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، ومع ذلك جعلوا له هؤلاء الشركاء؛ ولذلك تجد في سياق الآيات كقوله تعالى: ![]() بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ
بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ![]() [الأنعام:101] أن هذا المعنى من الإثبات يُقصد به بيان الامتناع، فإذا تأملت هذه الآية في ذكر إبطال ما ذكره المشركون من الشركاء من الجن، أو من الولد، أو غير ذلك مما لا يليق به سبحانه وتعالى، ولا بتوحيده، وربوبيته، وألوهيته، وعبادته، تجد أنه يستعمل في القرآن مبنياً على إثبات حقائق فطرية عقلية تكون مانعةً من هذا الطارئ الذي ادعاه المخالفون.
[الأنعام:101] أن هذا المعنى من الإثبات يُقصد به بيان الامتناع، فإذا تأملت هذه الآية في ذكر إبطال ما ذكره المشركون من الشركاء من الجن، أو من الولد، أو غير ذلك مما لا يليق به سبحانه وتعالى، ولا بتوحيده، وربوبيته، وألوهيته، وعبادته، تجد أنه يستعمل في القرآن مبنياً على إثبات حقائق فطرية عقلية تكون مانعةً من هذا الطارئ الذي ادعاه المخالفون.
فالله سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض، وهذا من الحقائق الفطرية العقلية الضرورية.
ولذلك فإن الله ذكر في سياق الآية قوله تعالى: ![]() بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ
بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ![]() [الأنعام:101] أي: لما كان سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض؛ امتنع أن يكون له شريك في الملك، أو أن يكون له ولد، أو نحو ذلك؛ ولذلك قال:
[الأنعام:101] أي: لما كان سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض؛ امتنع أن يكون له شريك في الملك، أو أن يكون له ولد، أو نحو ذلك؛ ولذلك قال: ![]() بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ
بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ![]() [الأنعام:101] أي: يمتنع أن يكون له ولد وهو بديع السماوات والأرض.
[الأنعام:101] أي: يمتنع أن يكون له ولد وهو بديع السماوات والأرض.
فهذه الطرق النبوية القرآنية في الرد على المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام هي الطرق الصحيحة، وهي طرق عقلية، وبذلك يقضى على هذه الشُّبَه والطارئات بما هو من اليقينيات الضروريات.
وهنا قاعدة شرعية وهي: (أن كل من ادعى غلطاً أو نقصاً فيما جاءت به الرسل، فلا بد أن في دين الرسل من اليقينيات والضروريات ما يدفع هذا الإشكال)، فمن ادعى نقصاً في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حديث أو حرف من كلامه؛ فإنه يراجَع في أصل الإيمان بالنبوة، فإذا أقر أنه نبي وآمن بحقيقة النبوة؛ فإن حقيقة النبوة وحقيقة الرسالة معناها أنه لا ينطق عن الهوى.
ولذلك إذا جاء شخص مثلاً متأثر بالغرب، أو مائل إلى شيء من طرقهم، أو منحرف عن الصواب، وأراد أن يجادل في بعض الحقائق الشرعية، فالإغلاق معه أن يُسأل: هل تقر بأن هذا شرعي أم ليس شرعياً؟
أما أن يؤخذ معه على التفصيل فإن هذا قد لا يحيط به أحد؛ لأن الحكم الإلهية لم تفصِّل للعباد، والله تعالى لم يذكر لعباده سائر الحكم؛ بل ذكر جملة منها.
قال المصنف رحمه الله: [ وقال تعالى: ![]() تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً * الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً * الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ![]() [الفرقان:1-2] وقال تعالى:
[الفرقان:1-2] وقال تعالى: ![]() فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ
فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ ![]() [الصافات:149] ].
[الصافات:149] ].
هذا امتناع عقلي، وهذا من التنزيه لله سبحانه وتعالى؛ أنه يمتنع أن يكون له شيء من البنات، وكيف يجعل المشركون له البنات ولهم البنون؟! إلى غير ذلك.
وقوله تعالى: ![]() فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ * أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ
فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ * أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ ![]() [الصافات:149-150] هذا دليل عقلي بسيط يرد الله به زعم المشركين أن الملائكة إناث، فرد الله عليهم بقوله:
[الصافات:149-150] هذا دليل عقلي بسيط يرد الله به زعم المشركين أن الملائكة إناث، فرد الله عليهم بقوله: ![]() أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ
أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ ![]() [الصافات:150] أي: هم لم يشاهدوا ذلك، فكيف يقولون: إنهم إناث أو ليسوا إناثاً؟! فإن من بسائط وضروريات العقل أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهم لم يشاهدوا خلق الملائكة، فكيف حكموا بأن الملائكة إناث؟!
[الصافات:150] أي: هم لم يشاهدوا ذلك، فكيف يقولون: إنهم إناث أو ليسوا إناثاً؟! فإن من بسائط وضروريات العقل أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهم لم يشاهدوا خلق الملائكة، فكيف حكموا بأن الملائكة إناث؟!
أقوال المشركين الباطلة المذكورة في القرآن على وجهين
بيَّن الله سبحانه أنه ليس لهم سلطان ولا حجة، وإنما قولهم من باب الإفك، والله تعالى إذا ذكر ما تقوله الأمم المشركة فإن ما يذكره عنهم على أحد وجهين:
الوجه الأول: أن يكون من باب الإفك، وهو الشيء الذي يقولونه وليس عندهم مادة تدل عليه، فهذا يسميه الله تعالى في كتابه إفكاً، وهو القول الذي يقولونه وهو مجرد عن أدنى مواد الاستدلال، كقولهم: الملائكة إناث، مع أنهم لم يشهدوا خلقهم.
الوجه الثاني: أن يأتي ما يذكره هؤلاء في القرآن ويسمى ظناً، وهو المذكور في مثل قول الله تعالى: ![]() إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ![]() [الأنعام:116]
[الأنعام:116]
والغالب في المسائل الخبرية أن القرآن يسمي ما يقولونه: إفكاً، وإذا عارضوا في مقام التشريع يسمى ما يزعمونه ويعترضون به: ظناً، وهذا هو اللائق في المقامين، فإن المسائل الخبرية تدور على التصديق والتكذيب؛ ولذلك فإنهم إذا اخترعوا قولاً فإنه يسمى إفكاً وكذباً.
طريقة القرآن في الرد على المخالفين
هذه سياقات تامة ومحكمة، وهي آيات الله وكلماته سبحانه وتعالى، وفيها التحقيق لوحدانيته والدفع لسائر ما اعترض به المخالفون.
وهذه الآيات فيها عبرة من جهة تفصيلها ومن جهة كليتها، فالعبرة الكلية فيها أن يقال: إن طريقة القرآن في الرد على المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام هي رد المختلف فيه إلى المجمع عليه؛ فإن الحقائق -وحتى الحقائق الشرعية- قد تكون متفقاً عليها، وقد يقع في شيء من المسائل الشرعية ما يكون مختلفاً فيه، والفقهاء إذا نظروا في مسائل الفقه -فضلاً عن مسائل الرد على المخالفين- فإنهم يردون المسألة التي فيها نزاع إلى الأصول المتفق عليها في بابها.
والحكم على المختلف يكون على ضوء القاعدة العقلية وهي: الحكم على المختلف بالمؤتلف، حتى لو خالف المخالف بالهوى، أو بالظن، أو بالإفك، وما إلى ذلك؛ فهؤلاء المشركون مع أنهم كذبوا، كما قال الله عنهم: ![]() أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ
أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ![]() [الصافات:151] ومع ذلك أبطل الله سبحانه وتعالى ما يذكرونه من هذا الذي يزعمونه مختلفاً مشتبهاً، أبطله الله سبحانه وتعالى بما هو عندهم من المؤتلف، فإن المشركين من المؤتلف عندهم والمستقر عندهم أن الله بديع السماوات والأرض..
[الصافات:151] ومع ذلك أبطل الله سبحانه وتعالى ما يذكرونه من هذا الذي يزعمونه مختلفاً مشتبهاً، أبطله الله سبحانه وتعالى بما هو عندهم من المؤتلف، فإن المشركين من المؤتلف عندهم والمستقر عندهم أن الله بديع السماوات والأرض..
وهكذا إذا ناظرت أحداً ولو لم يكن من المخالفين لأهل السنة والجماعة؛ بل حتى في المسائل الفقهية، فإذا اختلفتَ أنت وآخر، أو قرأت في مسألة فقهية؛ تجد أن هذه المسألة الفقهية لها أصول في بابها، فترد المسألة المتنازَع فيها إلى أصول هذا الباب، فتقول: أنا أتمسك بهذا الأصل في هذا الباب، إلا أن يأتي دليل يخرج المسألة عن هذا الأصل.
مثال ذلك: إذا اختلفتَ أنت وآخر في زكاة حلي النساء -ومن المعلوم أن بين الفقهاء خلافاً في هذه المسألة، وأن الأئمة الثلاثة لا يرون وجوب الزكاة فيها خلافاً لـأبي حنيفة رحمه الله- فلك أن تقول: إن قاعدة الشريعة في باب الزكاة: (أن أموال القنية والارتفاق ليس فيها زكاة)، فالإنسان ليس عليه في لباسه، ولا في سيارته، ولا في مسكنه زكاة، حتى لو سكن الإنسان بيتاً بمليون ريال أو أكثر فليس عليه فيه زكاة.
وهذا الحلي الذي تستعمله النساء وتلبسه هو من قنيتها وارتفاقها، فمقتضى القاعدة في باب الزكاة أن مال القنية والارتفاق لا زكاة فيه؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) .
فتقول أنتَ: أنا أتمسك بهذا الأصل، إلا أن يأتي دليل يدل على أن حلي النساء يُستثنى من هذا الأصل، فتكون قد رددت المختلف فيه بين العلماء إلى المؤتلِف. فهذا منهج حسن في التفقه، وهو مستعمل في القرآن في تقرير الحقائق الشرعية، أو في الرد على المخالفين.
-
عامة الأمم لم يصفوا الله بالنقائص المطلقة
عامة الأمم لم يصفوا الله بالنقائص المطلقة
عامة الأمم لم يصفوا الله بالنقائص المطلقة؛ بل كانوا مقرين بأن الله هو رب العالمين، وأنه بديع السماوات والأرض، ويقرون بأصل الربوبية إقراراً مجملاً، لكن عرضت لهم بعض المقامات من جنس ما ذكره الله عنهم في القرآن، والأمم التي غلب عليها مقام النقص في حق الباري سبحانه هم اليهود، فإن الله قد ذكر عنهم من تنقيصه سبحانه وتعالى ما هو معروف، وهذا مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى في مثل قوله تعالى: ![]() وَقَالَتْ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ
وَقَالَتْ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ![]() [التوبة:30] وقوله:
[التوبة:30] وقوله: ![]() وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ
وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ![]() [المائدة:64] وغير ذلك.
[المائدة:64] وغير ذلك.
قال المصنف رحمه الله: [ وسلم على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات ].
من طرق استدلال الأئمة على إثبات صفات الله: أن العرب في جاهليتها لما نزل القرآن تكلفوا في دفع ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ![]() إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ
إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ![]() [النحل:103] وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ساحر، وكاهن، وغير ذلك، ومع ذلك لما نزل القرآن وفيه ذكر للأسماء والصفات لم يعترض أحد من المشركين ويقول: إن هذا مخالف للعقل؛ فدل ذلك على أن باب استحقاق الباري لصفات الكمال، وأن تنزيهه سبحانه عن صفات النقص باب فطري من حيث الأصل، ولكن الشريعة فصلته؛ ولذلك لم يعترض عليه مشركو العرب.
[النحل:103] وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ساحر، وكاهن، وغير ذلك، ومع ذلك لما نزل القرآن وفيه ذكر للأسماء والصفات لم يعترض أحد من المشركين ويقول: إن هذا مخالف للعقل؛ فدل ذلك على أن باب استحقاق الباري لصفات الكمال، وأن تنزيهه سبحانه عن صفات النقص باب فطري من حيث الأصل، ولكن الشريعة فصلته؛ ولذلك لم يعترض عليه مشركو العرب.
فإن قيل: إن المشركين تكلموا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لـعلي رضي الله عنه: (اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال
فالجواب: أن هذا لا يدل على أنهم كانوا ينفون الأسماء، إنما كان بعض العرب من الجاهليين يقف في هذا الاسم، أو لا يعرف هذا الاسم فينفيه، وهذا لا يدل على أنهم ينفون سائر الأسماء؛ بل كان من الجاهليين من يتسمى بعبد الرحمن، كـعبد الرحمن الفزاري الذي قتله أبو قتادة الأنصاري في غزوة ذي قَرَد، وقد كان هذا الأمر مألوفاً معروفاً في بعض بوادي العرب ومناطقهم.
فالمقصود: أن كون العرب لما نزل عليم القرآن لم يطعنوا في الأسماء والصفات بحجة المخالفة للعقل، هذا يدل على أن هذه السياقات موافقة للعقل والفطرة، ولو كانت مخالفة لعقولهم أو فطرهم لكان اعتراضهم عليها بالعقل أولى من قولهم عن الرسول قولاً يعلمون سقوطه، وهو قولهم: إنه ساحر، أو كاهن.
فيقول المصنف: إن الآيات السالفة هي من النفي المجمل، مع أنك إذا قرأت السياق وجدت فيه نفياً مفصلاً، وهذا ليس من باب أنها مقصورة على النفي المجمل، إنما أراد المصنف أن فيها تنزيهاً مجملاً، وإن كان فيها تنزيه مفصل، فالتنزيه المجمل في مثل ذكره سبحانه وتعالى لتنزيهه عن الولد، حيث بيَّن سبحانه وتعالى أنه منزه عن الولد وعن كل ما لا يليق به، وهذا معتبر بمراعاة السياق، ومراعاة سياق القرآن فيه حكمة شرعية لازمة لتحصيل المعاني.
ولذلك نقول: إن هذه السياقات لا تُسْتَشكل فيقال: كيف قال المصنف: إنها دلت على النفي المجمل وفيها نفي مفصل؟ وذلك لأن فيها نفياً مفصلاً، ونفياً مجملاً، وكل نفي مفصل فإنه يُذكر في مقام رده على جهة التنزيه المطلقة المتضمنة لتنزيهه سبحانه عن هذا النقص المذكور، وعن غيره.
 الأكثر استماعا لهذا الشهر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
-
38996
البوم روائع القصائد
عبد الواحد المغربي -
21851
أناشيد رمضانية منوعة
(...) -
19061
الرقية الشرعية - مشاري راشد العفاسي
-
14803
الشاطبية
الشيخ:عبد الرشيد بن الشيخ علي صوفي -
13727
قصص الأنبياء - قصة أيوب وذوالكفل- قصةأصحاب الرس- قصةذوالنون- قصة شعيب- قصةاهل القرية
طارق السويدان -
11410
منظومة عشرة الإخوان
توفيق سعيد الصائغ -
11197
أذان بصوت الشيخ ناصر القطامي
ناصر القطامي -
10795
الدرس الأول
سمير مصطفى فرج -
10072
هزتني
محمد المطري -
8166
مختارات لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
أبو علي

عدد مرات الاستماع
3087844787

 القرآن الكريم
القرآن الكريم علماء ودعاة
علماء ودعاة القراءات العشر
القراءات العشر الشجرة العلمية
الشجرة العلمية البث المباشر
البث المباشر شارك بملفاتك
شارك بملفاتك
 البث المباشر
البث المباشر