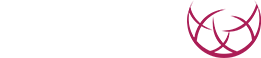الصوتيات
الصوتيات
- الصوتيات
- علماء ودعاة
- محاضرات مفرغة
- حسن أبو الأشبال الزهيري
- شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة
- شرح كتاب الإبانة - ترك السؤال عما لا يعني الدخول فيه [1]
-
باب ترك السؤال عما لا يعني الدخول فيه والبحث والتنقير عما لا يضر جهله ولا ينفع علمه
باب ترك السؤال عما لا يعني الدخول فيه والبحث والتنقير عما لا يضر جهله ولا ينفع علمه
وبعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
عودة إلى ما بدأناه من المحاضرات فيما يتعلق بمسائل الإيمان من كتاب (الإبانة) لـابن بطة وكنا قد شرحنا مواضيع من كتابه في بعض المحاضرات؛ لإلقاء الضوء على أصول بعض الفرق، وهذا الكتاب تناول أصول الفرق الضالة.
وموضوع اليوم هو من أخطر الموضوعات التي تمس العمل الإسلامي، والساحة الدعوية، فهو من الموضوعات التي ينبني عليها العمل، والتي يجب أن يتخلق بها السائر إلى الله عز وجل، وكذا طالب العلم، بل وكل مسلم عليه أن يتخلق بهذه الأصول التي سنتعرض إليها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ترك السؤال عما لا يعني ].
يعني: إذا كان الأمر لا يعنيك فينبغي عليك أن تترك السؤال عنه؛ لأن هذا من حسن إسلامك وإيمانك.
ثم قال: [ والبحث والتنقير عما لا يضر جهله، ولا ينفع علمه ].
يقول أهل العلم في بعض الأمور: العلم به لا ينفع، والجهل به لا يضر، فلم تبحث عنه، وتنقب وتضيع العمر فيه، وتترك ما قد فرض الله عز وجل عليك معرفته، تترك الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج.. وغير ذلك، ثم تبحث في أدق المسائل التي لا يحاسبك الله عز وجل عليها يوم القيامة؟!
ثم قال: [ من قوم يتعمقون في المسائل، ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين ] يعني: سواء حرصت على ذلك لنفسك، أو حرصت على صحبة من تخلق بهذا الخلق.
وهذا الباب يحذر من عدة مسائل:
المسألة الأولى: السؤال عما لا يعني.
المسألة الثانية: التحذير من التنقير والتنقيب عما لا يضر جهله، ولا ينفع العلم به.
المسألة الثالثة: التحذير من صحبة قوم يتعمقون ويتشدقون في دين الله عز وجل، فإما أن تكون أنت الذي تصنع ذلك فتنتهي بنهي الله تعالى ورسوله لك، وإما أن تنتهي عن صحبة قوم تخلقوا بهذا الخلق.
إذاً: فهذه المسائل الثلاث من أعظم ما يمكن أن يتخلق به طالب العلم في هذا الزمن، وإلا ضاع وقته.
أسباب خروج الناس عن السنة والجماعة إلى البدعة والشناعة
أي: فكرت وتدبرت في الأسباب التي أخرجت أقواماً من عداد أهل السنة والجماعة، وأدخلتهم في عداد أهل البدع.
قال: [ واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم، وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين ] يعني: هناك سببان أديا بهؤلاء الأقوام إلى ترك الحق، والتنافس في الباطل.
قال: [ أحدهما: البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني، ولا يضر العاقل جهله، كما أنه لا ينفع المؤمن فهمه ].
أي: النهي عن كثرة السؤال فيما لا يعني، وأما إذا كان السؤال مبناه على الفهم والعلم والعمل فلا حرج فيه شرعاً، بل هو واجب، يقول الله تعالى: ![]() فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ![]() [النحل:43]، بل يشرع كذلك للعالم أن يسأل عما يعلمه إذا كان القصد نشر العلم وبثه في الناس.
[النحل:43]، بل يشرع كذلك للعالم أن يسأل عما يعلمه إذا كان القصد نشر العلم وبثه في الناس.
قال: [ والآخر: مجالسة من لا تؤمن فتنته، بل وتفسد القلوب صحبته ]، فلست فقط منهياً عن فساد قلبك أو تجنبك للفتنة، بل أنت مطالب أيضاً أن تجتنب أهل الأهواء بألا تصاحبهم، ولا تقترب منهم، بل تفر منهم فرارك من الأسد؛ لغلبة الفتنة، وانتصار الشر، وغلبة الفساد، وربما أثر عليك في قلبك فوقعت في المحذور.
قول النبي: (اتركوني ما تركتكم)، ونهيه عن كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء
فيبدأ رحمه الله بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم قال: [ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتركوني ما تركتكم) ], وهذا الخطاب في عمومه موجه للأمة كلها، وليس خاصاً بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: [ (اتركوني ما تركتكم) ] يعني: لا تجادلوني ولا تخاصموني ولا تسألوني حتى أبادركم بالعلم.
وجاء في الحديث: (قام رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام -لما فرض الله عز وجل الحج- فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد عليه ثانية: يا رسول الله آلحج كل عام؟ فسكت، حتى أعادها عليه ثلاثاً، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم) يعني: لو رددت عليك بالإيجاب لكان الحج واجباً على كل مسلم في كل عام، والمعلوم قطعاً أن أحداً لا يقدر على ذلك، والحج فرض في العمر مرة، وما دون ذلك فهو نافلة.
ثم قال: [ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (ذروني ما تركتكم) ] يعني: إذا لم أحدثكم بشيء ابتداءً فلا تحدثوني وتنازعوني وتخاصموني وتحاجوني فيه؛ لأن هذا كان سبب هلاك الأمم من قبلكم: كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم، فسبب هلاك بني إسرائيل وسبب ضلالهم: أن الله شدد عليهم لما شددوا على أنفسهم.
فمثلاً: قصة البقرة، فقد فرض الله تعالى على بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، ثم سألوا عن هيئة البقرة، ولون البقرة، وصفات البقرة، ولو سكتوا من أول الأمر لكان يجزئهم ذبح أي بقرة، ولكنهم شددوا وتعنتوا حتى اختار الله عز وجل لهم بقرة واحدة لا مثيل لها، فبحثوا عنها ونقبوا عنها وتعبوا أيما تعب، ولما وصلوا إلى البقرة المعلومة المعينة المذكورة بأماراتها وأوصافها غالى صاحبها أيما مغالاة في ثمنها، فوقعوا في مشقة أخرى؛ لأنهم لم يسمعوا ويطيعوا من أول الأمر، بل جادلوا وكثرت أسئلتهم.
النهي الشرعي في مقدور كل إنسان تطبيقه بخلاف الأمر
قال: [ وفي رواية عند مسلم وأحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم) ]، وهناك: (بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، واختلافهم - أي: على أنبيائهم-، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا) ].
بيان أن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته
أي: أعظم الناس جرماً رجل يتنطع ويسأل، ويتعمق في قضية لم ينزل فيها تشريع، فينزل التشريع بتحريم هذه المسألة لأجل سؤاله، وإلا فالحرام ما حرمه الله عز وجل في كتابه، وما حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، والحلال ما أحله الله في كتابه، وما أحله النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فلا تسألوا عن أشياء سكت عنها الشرع، إن تسألوا عنها وتجحفوا في المسألة وبدت لكم تسؤكم؛ وذلك بأن تحرم عليكم، فتقعون في الحرج والمشقة؛ بسبب أنكم تعمقتم وتنطعتم، ودخلتم فيما لا يعنيكم، وسألتم عما لم تكلفوا بالسؤال عنه.
قال الخطابي في كتاب (معالم السنن): (هذا في مسألة من يسأل عبثاً وتكلفاً فيما لا حاجة به إليه، دون من سأل سؤال حاجة وضرورة) يعني: أن الذي يسأل للتعلم والعمل لا حرج عليه في ذلك، وهو مأمور بذلك، وأما الذي يسأل تكلفاً وتنطعاً فهذا هو المعني بهذا النهي.
النهي عن الاستعجال بالبلية قبل نزولها، فإن العجلة تشتت السبل
هذا الحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن بعض أهل العلم قد حسنه، ولو اتفقنا على تضعيفه لقلنا كان عليه العمل في زمن الصحابة ومن بعدهم، وهذا الحديث ظاهره يقضي بأن المرء لا يسأل عن الشيء حتى يكون ويقع، أما أن يفترض المرء ويتصور أمراً لم يقع بعد، ثم يتكلف المسألة وسؤال أهل العلم هنا وهناك، كأن يقول: هب أن أمراً حصل وكان كيت وكيت، فماذا يكون الجواب؟ ألم تعلموا أن معظم الشر والبلاء الذي دخل في كتب الفقه.. وغيرها إنما هو من: أرأيت .. أرأيت، أرأيت لو كان كذا، ماذا يكون؟ وأرأيت لو كان كذا، ماذا يكون؟ ولكن أهل السنة والجماعة متفقون على ألا يتكلموا في أمر إلا إذا نزل وصار واقعاً، فإذا صار واقعاً قيض الله عز وجل له من يجتهد فيه، وإذا قيض له من يجتهد فيه سدده الله تعالى ووفقه.
تحليف السلف للسائل عن وقوع المسألة من عدمه
بيان أن التنطع والتعمق مهلكة لصاحبه
قال الخطابي : (المتنطع: هو المتعمق في الشيء، المتكلف للبحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم).
يعني: كأن يسأل شخص عن دقيقة من دقائق المسائل التي لا ينبغي أن تخطر على بال أحد، ومع هذا هو غير متفقه في أصول دينه، لا في أصول الإسلام: من توحيد وصلاة وصيام وزكاة وحج، ولا في أصول الإيمان: من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا الإيمان بملائكته والأنبياء، والجنة والنار، والقدر خيره شره، فيترك هذا كله ولا يسأل فيه شيئاً، ولم يتعلم الواجب والفرض الذي يضره جهله في أصول الدين في الإسلام والإيمان، ثم هو يبحث عن دقيقة من الدقائق، ويشغل حياته كلها بهذه الدقيقة، ويتنطع فيها.
فمثلاً: لو دخل شخص الآن المسجد وهو لا يعرف شيئاً عن صلاة، ولا عن صيام، ولا زكاة، ولا أي شيء، فأول ما دخل سمع الشيخ يتكلم عن دار الإيمان ودار الكفر، فمن حين خرج من هذه الخطبة جعل حياته كلها بحثاً عن دار الإيمان ودار الإسلام ودار الكفر، وتقابله بعد سنة أو بعد عشر سنوات أو بعد عشرين سنة وهو لا زال قائماً يبحث في أول موضوع سمعه مع أول دخلة دخلها بيتاً من بيوت الله عز وجل، هل ينفع هذا الكلام؟! هو يبحث عن دقيقة لا تعنيه أصلاً؛ لأنه قدم ما حقه التأخير، وأخر ما حقه التقديم، بل الذي أخره هو يجهله تماماً، ويتصور أنه غير مكلف بالبحث عنه، وهو الذي يبنى عليه العمل، وهو الذي يسأل عنه يوم القيامة.
فقوله: (هلك المتنطعون) هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق: أن كل من تنطع في دين الله فهو هالك.
ومعنى كلمة: (هلك) أي: انقطع به الطريق، ولذلك ما وجدنا متشدداً في دين الله عز وجل إلا ولا بد أنه ينقطع، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام : (ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه) يعني: كل من تنطع في الدين وتعمق فيه على غير ما ذكر؛ فلا بد أن يغلبه الدين وأن يرده، فإن كان من أهل التوفيق والسداد رده إلى أصل الديانة والحنيفية السمحة، وإن كان من أهل التعنت لا بد أن يبتلى.
وقد حدثني رجل عن آخر أنه رافق المتنطعين منذ عشر سنوات وزيادة وإلى الآن لم يهلك ولم ينقطع، حتى أخبرني صاحبه منذ ثلاثة أيام أنه ترك صحبة فلان، قلت: ولم؟ قال: لأنه يقول بضلال كل العلماء والشيوخ والدعاة على الساحة إلا ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة هم فعلاً من أهل العلم، لكنهم على أية حال مغمورون؛ لأنهم لا يحبون الظهور، وهم من أهل العلم والحجة حقاً نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله.
وأما الحكم على جميع الشيوخ والدعاة والعلماء على الساحة بالضلال، وأنهم ليسوا من أهل الأصول ولا من أهل العلم على الحقيقة؛ فهذا بلا شك تنطع وغلو، بل هو غرور وكبر، حتى ذكر عن واحد من أكابر أهل العلم ممن ألان الله عز وجل له النصوص الشرعية كما ألان الحديد لداود عليه السلام، يقول هذا الغبي الأحمق: جلوسي على المقهى أحب إلي من بقائي في درس الشيخ محمد عبد المقصود.
فأقول: إن هذا الشخص إن شاء الله تعالى ليس أهلاً لحضور درس الشيخ ولا غيره، وإنما محله بإذن الله تعالى في المستقبل أن يبيع كتبه كما باع غيره كتبه، فقد سبقه المتنطعون والهلكى فباعوا مكتباتهم المجلد بجنيه واحد، وبلغ من حماقتهم أنهم باعوا من الكتاب الذي يضم عدة مجلدات مجلداً أو مجلدين، فهم ما باعوا الكتاب كله وإنما فرقوه في البيع، فرق الله تعالى شملهم.
قلّة المسائل التي سألها الصحابة للنبي حتى قبض
![]() يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ![]() [البقرة:219].
[البقرة:219].
![]() يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى ![]() [البقرة:220].
[البقرة:220].
![]() وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ![]() [البقرة:222] ].
[البقرة:222] ].
إلى آخر مسائل الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن على سبيل الجواب للأمة المباركة إلى قيام الساعة؛ لتنتفع بها، وليظهر الحكم في هذه المسائل من الحل والحرمة، والآداب والأحكام.. وغير ذلك.
ولم يذكر الراوي أكثر مما ذكر هنا، والمسائل في القرآن معروفة مشهورة.
بيان حديثي: (إن الله كره لكم ثلاثاً)، و (نهى النبي عن الأغلوطات)
[ وعن عيسى بن يونس قال: حدثني الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات).
قال عيسى بن يونس : الأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف ].
يعني: البحث والتنقير عن مسائل لم يكلف المرء بالبحث عنها، أو الخصومات في الدين.
وبعض أهل العلم يسمي الأغلوطات: الخصومات في الدين، والمجادلات والمنازعات والاشتباكات التي تدور بين الشباب في مسائل لا علم لهم بها.
ومن أعجب الأعاجيب أن اثنين يختلفان في مسألة، وفي وجه الحق والصواب فيها، فيتبنى هذا رأياً والآخر يتبنى رأياً آخر، وكلا الرأيين ليسا من آراء أهل العلم، فيحتكمان إلى ثالث ليس من أهل العلم! فلا يردان الأمر إلى كتاب الله عز وجل، ولا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا إلى اجتهاد أهل العلم، وإنما يتحاكمان إلى من هو أجهل منهما، فيكثر الخلاف؛ ولذلك يقول ابن حزم: لو سكت الجاهل لقل الخلاف. وذلك أن الجاهل يأبى وتأبى عليه نفسه الأمارة بالسوء إلا أن يتكلم فيما لا يعنيه، وخاصة في دين الله عز وجل.
[ عن عبادة بن نسي قال: (تذاكروا عند
وعن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات).
قال الأوزاعي : شداد المسائل وصعابها ].
ضرورة التأهل العلمي عند الدخول في المناظرات والجدال
فلقيني بالأمس فقال: الدكتور الفلاني يقول: إن الإمام البخاري صنف صحيحه من ست عشرة نسخة كنسخ التوراة والإنجيل، فكيف نرد عليه. فقلت له: وهل عنده أسئلة أخرى؟ قال: نعم، السؤال الثاني: قال: إن حديث الذبابة الذي أخرجه البخاري يغلب على راويه النكارة، قلت: والثالث؟ حتى عد سبعة أسئلة.
منها: إنكار شفاعة إبراهيم عليه السلام بالذات، قلت لماذا إبراهيم عليه السلام؟ قال: لأن إبراهيم صرح بأنه كذب ثلاث كذبات، قلت: غيره من الأنبياء صرح بمثل هذا، فلم منعت إبراهيم من الشفاعة بالذات؟! قلت له: لقد أخبرتني آنفاً أنك عالم كبير في مقارنة الأديان، فكيف تخفى عليك مثل هذه المسائل؟ ولو أن قسيساً في الكنيسة تناظر معك وألقى عليك هذه الأسئلة فماذا ترد عليه؟ قال: أنا ما عندي خبر غير هذا، قلت: إذاً ستفتضح حجتك أمام العالم في المناظرة، فتكون بذلك قد أفسدت على نفسك، وأوقعت المسلمين في الفتنة والحرج بانتصار هذا القسيس عليك، أليس كذلك؟ فسكت.
فقلت له: إنما مثلك كمثل رجل دخل المسجد فحرص أن يصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والصبح ثنتين، ولا علاقة لك في دين الله عز وجل فيما لا يعنيك، كما أنه يحرم عليك أن تنظر في كتب أهل الكتاب، فخاصمني وامتنع عن محادثتي إلى يومنا هذا، وأنا من الأمس إلى اليوم قد ألقيت عليه السلام ثلاث مرات في المسجد المجاور لبيتي فلم يرد علي السلام! فهل مثل هذا ينفع أن يفرض نفسه على الأمة أنه عالم كبير في مقارنة الأديان؟! مثل هؤلاء السفهاء الذين في الجامعات يسمونهم: دكاترة وفقهاء في الأديان، وعلم الفلسفة، والمنطق، فيقدمون دراسة هذه العلوم على دراسة كتاب الله عز وجل، ويزعمون أن دراسة هذه المواد إنما هي مفاتيح لكتاب الله عز وجل، وهؤلاء المفتونون المجرمون آل بهم الأمر إلى محاربة الله تعالى ورسوله جهاراً نهاراً.
ذم السلف لمن يجيء بشرار المسائل
وقال: إن شرار عباد الله قوم يجيئون بشرار المسائل؛ يعيبون بها عباد الله ].
يعني: يعيبون بها أهل العلم، كأن يأتي إنسان ويسأل عما لا يعنيه، ويتعمد إحراج المسئول.
قال: [ قال أحمد بن جناب المصيصي : سألت عيسى بن يونس عن قول الله عز وجل: ![]() كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ![]() [الرحمن:26]، فإن الحور العين يمتن، قال: فغضب عيسى من ذلك غضباً شديداً، فقال: لقد بعثرنا الحديث بعثرة ما بعثرها أحد -يعني: جمعنا الحديث جمعاً من كل قطر ومصر- ما بقي كوفي ولا بصري ولا مدني ولا مكي ولا حجازي ولا شامي ولا جزري إلا وقد لقيناه وسمعنا منه، ما سمعنا أحداً قط يسأل عن مثل هذا.
[الرحمن:26]، فإن الحور العين يمتن، قال: فغضب عيسى من ذلك غضباً شديداً، فقال: لقد بعثرنا الحديث بعثرة ما بعثرها أحد -يعني: جمعنا الحديث جمعاً من كل قطر ومصر- ما بقي كوفي ولا بصري ولا مدني ولا مكي ولا حجازي ولا شامي ولا جزري إلا وقد لقيناه وسمعنا منه، ما سمعنا أحداً قط يسأل عن مثل هذا.
ثم قال: ما لكم ومجالسة أهل الأهواء ومحادثتهم؟ ].
أي: لماذا تجالسونهم وتتحدثون معهم؟ وكثير من الناس جرته الحمية في مجالسة أهل الأهواء، ثم يقع في نفس الهوى وفي نفس البلية، فمثلاً: يريد أن يجلس مع جماعة التكفير أو أي جماعة على بدعة معينة؛ ليتعرف على مداخل ومخارج البدعة، فنقول له: هل أعدت لكل بدعة دليلاً ينقض هذه البدع؟ وهؤلاء لا يعرفون شيئاً من دين الله شيئاً إلا ما ظنوا أنهم قد عقلوه من بدعتهم، فإذا بهذا الشخص يجلس أمام مناظرهم ومجادلهم فيلقي عليه الشبهة ثم الشبهة ثم الشبهة، وهو لا علم له أصلاً بدين الله عز وجل، ولكن أخذته العاطفة والحمية أن يناظر أهل البدع؛ حتى يردهم بزعمه عن بدعتهم، فإذا به بعد إلقاء الشبهات عليه، وعدم قدرته على رد هذه الشبهات؛ يشربها هو، ويشربها قلبه، ثم يتذبذب ويتشكك، فيلقون عليه بالشبهات الأخرى والحجج المتكررة التي لا جواب عنده على واحد منها، ثم إذا هو يرجع وقد شك فيما كان عليه من الحق، وأيقن بما قد سمعه من شبهات.
فنقول لهذا وأمثاله: أنت لا زلت بعد في بداية طلبك للعلم، ولست مطالباً بالمناظرة والمجادلة مع هؤلاء، وإنما المجادلة والمناظرة تكون من أهل العلم الأثبات لا من طلاب العلم المبتدئين في العلم.
ذم السلف لمن يجالس أهل الأهواء فيتيه ثم يطلب من يجادله ليهديه
ولا مانع بتعدد الحوادث وأن السؤال وجه لـمالك، ووجه لـابن سيرين .
فأتى رجل إلى مالك ليناظره في ربه، ويجادله في إلهه، [ فقال مالك : أما أنا فعلى بينة من ربي -أي: لا أحتاج إلى مناظرة ومجادلة-، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه.
وقال: يلبسون على أنفسهم، ثم يطلبون من يعرفهم ويهديهم ] يعني: هم الذين يوقعون أنفسهم في الشك والحيرة والتيه، ثم هم بعد ذلك يأتون فيسألون لأجل الهداية.. وغير ذلك.
[ وعن سالم بن أبي حفصة قال: إن من قبلكم بحثوا ونقروا حتى تاهوا ] يعني: تكلفوا البحث والتنقير عما لا يعنيهم حتى وقعوا في التيه والحيرة.
تقسيم يحيى بن معاذ الرازي الناس إلى خمس طبقات، ومنها المتعمقون في الدين
لكن الإمام ابن بطة اختصر كلامه اختصاراً شديداً جداً، حتى إنه لم يذكر الطبقة التي يؤمر العبد بالتزامها، وهم أهل السنة والجماعة.
وأما الأربع التي أمر يحيى بن معاذ باجتنابها فلم يذكر منها ابن بطة إلا طبقة واحدة فقال: [ والطبقة الرابعة: هم المتعمقون في الدين، الذين يتكلمون في العقول، ويحملون الناس على قياس أفهامهم، قد بلغ من فتنة أحدهم، وتمكن الشك من قلبه: أنك تراه يحتج على خصمه بحجة قد خصمه بها، وهو نفسه من تلك الحجة في شك ].
يعني: أن هذا الشاك هو نفسه غير مؤمن بهذه الحجة، ولذلك إذا أتاه شاك آخر بحجة هي أقوى من حجته تحول إليها، وترك حجته السابقة التي قد خصم بها خصمه وانتصر عليه، قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه خصومات أكثر التحول. يعني: يتحول من دليل إلى دليل؛ لأنه لا يعتقد دليلاً واحداً، بل كلما رأى أن هذا الدليل أحسن وأجمل وأطيب من غيره تحول إليه.
قال: [ وهو نفسه في تلك الحجة في شك، ليس يعتقدها ولا يجهل ضعفها، ولا ديانة له فيها، إن عرضت له من غيره حجة هي أوثق منها انتقل إليها، فدينه محمول على سفينة الفتن، يسير بها في بحور المهالك، يسوقها الخطر، وتسوسها الحيرة، وذلك حين رأى عقله أملى بالدين، وأضبط له، وأغوص على الغيب ] يعني: دائماً يعتمد على عقله في التنقيب عن أمور الغيب التي لم يكلف بالبحث عنها.
ثم قال: [ وأبلغ لما يراد من الثواب من أمر الله إياه، ونهيه وفرائضه الملجمة للمؤمنين عن اختراق الشذوذ، والتنقير عن غوامض الأمور، والتدقيق الذي قد نهيت هذه الأمة عنه؛ إذ كان ذلك سبب هلاك الأمم قبلها، وعلة ما أخرجها من دين ربها، وهؤلاء هم الفساق في دين الله عز وجل المارقون منه، التاركين لسبيل الحق، المجانبون للهدى، الذين لم يرضوا بحكم الله في دينه حتى تكلفوا طلب ما قد سقط عنهم طلبه، ومن لم يرض بحكم الله في المعرفة حكماً لم يرض بالله رباً، ومن لم يرض بالله رباً كان كافراً، وكيف يرضون بحكم الله في الدين وقد بين لنا فيه حدوداً، وفرض علينا القيام عليها، والتسليم بها، فجاء هؤلاء بعد قلة عقولهم، وجور فطنهم، وجهل مقاييسهم يتكلمون في الدقائق، ويتعمقون، فكفى بهم خزياً سقوطهم من عين الصالحين، يقتصر فيهم على ما قد لزمهم في الأمة من قالة السوء، وألبسوا من أثواب التهمة، واستوحش منهم المؤمنون، ونهى عن مجالستهم العلماء، وكرهتهم الحكماء، واستنكرتهم الأدباء، شكاكون جاهلون، ووسواسون متحيرون، فإذا رأيت المريد يطيف بناحيتهم فاغسل يدك منه ولا تجالسه ].
يعني: إذا رأيت المبتدئ يطوف حولهم، ويحضر مجالسهم؛ فاغسل يدك منه، واعلم أنه لا خير فيه، فطالب العلم إذا ذهب عند المبتدع وصاحب هوى فاغسل يدك منه لا من صاحب البدعة؛ فإن هذا أمره مفروغ منه، ولكن اغسل يدك من ذلك الذي يحرص على مجالسته، واعلم أنه لا خير فيه.
ذكر بعض المسائل التي لا يجوز للسائل أن يسأل عنها، ولا للمسئول أن يجيب عنها
كان السلف رضي الله عنهم إذا ذكر القدر أمسكوا، وإذا ذكر النجوم أمسكوا، وإذا ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمسكوا، وهذه أمور متفق عليها، فما كان أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في القدر قط، ولم يثبت أن صحابياً تكلم في القدر، وكل ما هنالك إذا سئل أحدهم عن القدر قال: إن الله على كل شيء قدير، فكل قارئ للقرآن يقرأ هذا، وكل مطلع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على هذا، ولم يفسروا ويؤصلوا ويقعدوا لنا مسائل القدر التي كتبت فيها هذه الكتب التي لا نهاية لها، وإنما كانوا يؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن كل ذلك من عند الله، كما جاء ذلك في تعريف الإيمان في غير ما حديث: (وأن تؤمن بالقدر خيره وشره) أي: أنه من عند الله عز وجل، وأن الله على كل شيء قدير.
فالسلف خاصة الصحابة ما زادوا في القدر عن هذه الكلمات اليسيرات، ولو أنك أتيت الآن بأكابر المثقفين لنازعك في القدر أيما منازعة، وخاصمك فيه أيما مخاصمة، حتى يقول القائل: إذا كان الله تعالى قد قدر علي هذا العمل فلم يعذبني؟ وإذا كان الله تعالى قد كتب لي الجنة فلم العمل إذاً؟ لا بد أن يصل الأمر بمثقفي العصر إلى هذه المشكلة؛ لأن أسلافهم من القدريين ومن السالكين على غير هدى قد وجهوا هذه الأسئلة لسلف الأمة، ولذلك كان الصحابة إذا ذكر القدر أمسكوا، مع إيمانهم الجازم بأن كل شيء من عند الله، وأن الله تعالى كتب كل شيء من الخير والشر.
قوله: (وإذا ذكر الصحابة أمسكوا) أي: إذا ذكر الصحابة بما دار بينهم من خلاف؛ أمسكوا، وعلموا أن السنة في ذلك حب الصحابة أجمعين، والترضي عنهم أجمعين، وأن الله تبارك وتعالى غفر لهم ورضي عنهم، كما حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته في الصحيحين وغيرهما من الكلام فيهم وسبهم، وبين أن أحدنا لو أنفق مثل أُحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.. إلى آخر فضائل الصحابة في كتاب الله عز وجل، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
لكن هؤلاء لا بد أن ينشروا الفتن التي دارت بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولا بد من الخوض في هذا، بل يخرج بعض من لا يفهم أمور الدعوة، ولا يفهم قدرات الخلائق على استيعاب هذا الأمر، فينشر على مسامع العامة ما دار بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمرنا بالسكوت والترضي عنهم.
الشيعة في مصر
ومنذ عشر سنوات أو يزيد قليلاً ظهر هذا الكلب الذي يدعى حسن شحاتة، وهو إمام مسجد الجامعة في مقابلة الجامعة الجديدة، وقال ما قال في شأن الصحابة، خاصة في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، قال كلاماً هو كفر بواح، ثم تألب الرأي العام والصحافة وغير ذلك في ذلك الوقت على هذا الكلب، وسجن مدة من الزمان، لكن لوساطة بعض الوجهاء الشيعة في لبنان قام بعضهم بزيارة لمصر خاصة لإخراجه من السجن، وخرج هذا الكلب، وأنا على يقين أن الحكومة المصرية تخشى التشيع، وتخاف من ظهوره وانتشاره في مصر؛ لأن الشيعة في إيران شكيمتهم قوية جداً.
والدرس الذي تلقاه صدام حسين من خميني إيران وشعب إيران لا يمكن أن تنساه الحكومة المصرية، ولا غيرها من الحكومات.
والآن تهاونت الحكومة المصرية مرة أخرى بعد أن أخذت موقفاً حاسماً منذ عشر سنوات فيما يتعلق بظهور الشيعة في مصر خاصة في المنصورة، فمنبع التشيع هو في المنصورة، وإن شئت فقل: المنصورة في المرتبة الثانية بعد حي شبرا في القاهرة.
وللأسف الشديد ظهرت مجلة في مصر من عدة أشهر، هذه المجلة اسمها: أهل البيت، وأهل البيت -يعلم الله- أنهم بريئون جميعاً ممن ينتسب إليهم من الشيعة.
فهذه المجلة إنما تتقرب إلى مولاها بزعمها بتكفير أبي بكر وعمر وعثمان ، وردة عائشة رضي الله عنها، واتهامها بالفاحشة، وأن حادثة الإفك ليست حادثة وهمية، بل هي حادثة حقيقية، وأن عائشة حقاً وقعت في الزنا، هكذا قالوا، ولا تزال هذه المجلة تصدر على قدم وساق في كل شهر مرة على مسمع ومرأى من الحكومة المصرية، فلم لا تقوم الحكومة المصرية بمصادرة هذه المجلة ومعاقبة القائمين عليها؟ ماذا تنتظر؟ هل تنتظر أن يستفحل الأمر ولا يمكن علاجه؟! فكل ثلم يبدأ بعفن.
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر
هل تنتظر الحكومة حتى يكون الشيعة في مصر بالملايين؟ إن شاء الله لا يكونون كذلك، لكن ولو كان واحداً فلابد من حربه، أما سمعتم أن صبيغاً الذي كان يتكلم ويتعمق ويتنطع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لما سأل عن الذاريات والمرسلات.. وغير ذلك نظر عمر في وجهه فعلم أنه متنطع لا يقصد التعلم، فجلده وضربه، وقال: والله لو كنت حالقاً لضربت عنقك. وربما يأتي هذا الدليل معنا في هذا الباب لأنه من مظانه.
إذاً: فهناك من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها، كما لا يجوز للمسئول أن يجيب فيها، بل إذا سئلت في مسألة فقل: أثم هي؟ أوقعت؟ فإذا كانت قد وقعت فإن الله تعالى يسدد ويعين المجتهد في القضاء فيها أو الإفتاء فيها، وإذا لم تكن قد وقعت فيجب عليك أن تنهى السائل عن ذلك؛ لأن هذا ليس هو منهج السلف ولا منهج أهل السنة.
ضرورة الكف عما كف الشرع عنه، وعدم الخوض فيه
قال: [ وقال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول: قال رجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أر شيئاً مستقيماً ].
يعني: كأن هذا الرجل يقول: دخلت في القدرية والمعتزلة والمرجئة.. وغير ذلك من الفرق الكبار في زمن مالك فلم أر شيئاً منها مستقيماً.
[ فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبركم لم ذلك؟ -أي: لم دخل هذا الرجل في كل الأديان ولم ير شيئاً منها قط مستقيماً- قال: لأنك لا تتقي الله، فلو كنت تتقي الله جعل الله لك من أمرك مخرجاً ].
أي: نور بصيرتك، وهداك إلى معرفة الحق، والله تعالى يقول: ![]() وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ ![]() [محمد:17]، فالمهم أن يعقدوا قلوبهم على الهدى ويحبوه، ويبذلوا المهج في سبيل الوصول إليه، ثم الله تعالى يوفقهم لذلك بعلمه صدق نيتهم، أما من كان يتنطع ويتعمق ولا يريد الوصول إلى الحق؛ فإن الله تبارك وتعالى يضله، ويجعله يتيه في ظلمات الضلال هنا وهناك.
[محمد:17]، فالمهم أن يعقدوا قلوبهم على الهدى ويحبوه، ويبذلوا المهج في سبيل الوصول إليه، ثم الله تعالى يوفقهم لذلك بعلمه صدق نيتهم، أما من كان يتنطع ويتعمق ولا يريد الوصول إلى الحق؛ فإن الله تبارك وتعالى يضله، ويجعله يتيه في ظلمات الضلال هنا وهناك.
بيان النبي أن الله تعالى سكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بنا فلا نبحث عنها
هذه الأشياء التي سكت الله عز وجل عنها لا نتكلف نحن السؤال فيها؛ لأن الله تبارك وتعالى لما تركها تركها لنا من باب العفو، ومن باب المباحات، فمن فعلها كان له ذلك، ومن لم يفعلها فلا حرج عليه، فأما أن تتكلف البحث عنها، ومعرفة الحكم فيها؛ فإن هذا الأمر يسبب الحرج لصاحبه.
آثار عن السلف في ردهم الافتراضات في الأسئلة، والسؤال عما لم يكن
قال: [ فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا رأينا ].
يعني: لك أن تأتي بسؤالك الذي وقع، ولا تسأل عن غيره؛ لأنك منهي عن هذه الطريقة الجاهلية، فسؤالك الذي ينبني عليه العمل في سلوكك إلى الله عز وجل أنت مكلف به فقط دون سواه.
قال: [ وعن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تسألوا عن أمر لم يكن؛ فإن الأمر إذا كان أعان الله عليه، وإذا تكلفتم ما لم تبلوا به وكلتم إليه ].
يعني: يتخلى الله تعالى عنكم، ويكلكم إلى هذا، وربما أصبتم وربما خالفتم.
قال: [ وعن خارجة بن زيد بن ثابت قال: سئل زيد بن ثابت عن شيء فقال: أكان هذا؟ فقيل: لا، فقال: دعه حتى يكون؛ فإنما هلك من كان قبلكم بأنهم قاسوا ما لم يكن بما قد كان، حتى تركوا دين الله عز وجل.
وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا لا يسألون إلا عن حاجة.
وعن الشعبي قال: سل عما كان، ولا تسأل عما لم يكن ولا يكون ].
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
التمادي في الأسئلة والافتراضات قد يؤدي بالإنسان إلى السؤال عمن خلق الله
يعني: إذا كنت ممن يسأل كثيراً فلا بد أن تصل إلى عين هذا السؤال: (هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟) ولا بد أن تعلم أنك أضعف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأقل إيماناً؛ ولذلك حاك في قلوبهم وصدورهم هذا السؤال: [ (قالوا: يا رسول الله إن أحدنا لتحدثه نفسه بشيء لئن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو قد فعلها؟ -يعني: أو قد غلبكم عليها الشيطان؟- ذاك محض الإيمان) ] أي: تحرجكم أن تتكلموا بهذا الكلام دليل على إيمانكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (وإن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ فتقولون: الله، فيقول الشيطان: هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟ قال: فإذا بلغ الشيطان منكم ذلك المبلغ فاستعيذوا بالله وانتهوا، وقولوا: آمنا بالله ورسوله) ].
يحدد عليه الصلاة والسلام علاج شبه الشيطان بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان، والانتهاء، ومجاهدة النفس؛ حتى لا يستقر هذا الخاطر في القلب، بل يمر على القلب مروراً ولا يستقر فيه، ولا يتمكن منه، ثم بقولك: آمنت بالله ورسوله؛ لأن الشيطان يفر إذا سمع هذا الشيء.
فبين عليه الصلاة والسلام الجواب لهذا السؤال وعلاجه.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
 الأكثر استماعا لهذا الشهر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
-
39268
البوم روائع القصائد
عبد الواحد المغربي -
21909
أناشيد رمضانية منوعة
(...) -
19308
الرقية الشرعية - مشاري راشد العفاسي
-
15086
الشاطبية
الشيخ:عبد الرشيد بن الشيخ علي صوفي -
13800
قصص الأنبياء - قصة أيوب وذوالكفل- قصةأصحاب الرس- قصةذوالنون- قصة شعيب- قصةاهل القرية
طارق السويدان -
11448
منظومة عشرة الإخوان
توفيق سعيد الصائغ -
11285
أذان بصوت الشيخ ناصر القطامي
ناصر القطامي -
10850
الدرس الأول
سمير مصطفى فرج -
10270
هزتني
محمد المطري -
8189
مختارات لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
أبو علي

عدد مرات الاستماع
3087861462

 القرآن الكريم
القرآن الكريم علماء ودعاة
علماء ودعاة القراءات العشر
القراءات العشر الشجرة العلمية
الشجرة العلمية البث المباشر
البث المباشر شارك بملفاتك
شارك بملفاتك
 البث المباشر
البث المباشر