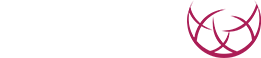الصوتيات
الصوتيات
- الصوتيات
- علماء ودعاة
- محاضرات مفرغة
- حسن أبو الأشبال الزهيري
- شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة
- شرح كتاب الإبانة - التحذير من الاستماع لأقوام يريدون نقض الإسلام وشرائعه
-
التحذير من سماع كلام قوم يريدون نقض الإسلام، ومحو شرائعه
التحذير من سماع كلام قوم يريدون نقض الإسلام، ومحو شرائعه
تستر أهل الباطل في طعنهم للإسلام وشرائعه بطعنهم في العلماء والرواة
وبعد.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أما بعد.
فقد توقفنا عند باب: التحذير من استماع كلام قوم يريدون نقض الإسلام، ومحو شرائعه، فيكنون عن ذلك بالطعن على فقهاء المسلمين وعيبهم، وهذا هو المرض العضال، لكنهم لا يجرءون أن يطعنوا في أحكام الإسلام مباشرة؛ لأنهم لا يجدون آذاناً صاغية، فيسلكون مسالك شيطانية أخرى، منها: الطعن في علماء المسلمين، أو الطعن في الرواة، ولذلك تجد أن أكثر الصحابة يطعنون فيه هو أبو هريرة رضي الله عنه، مع أن أبا هريرة ليس هو راوي الحديث فقط، وإنما هو أكثر الصحابة رواية للحديث، وعنده المؤهلات الشرعية والعلمية التي أهلته لأن يكون أكثر الصحابة رواية لعلم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان مغنم القوم بزعمهم الطعن في جل الشريعة؛ لأنها جاءت من طريق أبي هريرة ، عند ذلك لم يمكنهم التصريح بذلك، فلجئوا إلى الطعن في شخصية أبي هريرة ؛ لأن سقوط الثقة في الراوي هو سقوط لمروياته، فلما انبرت أقلام الكثيرين من علماء السنة للذب عن أبي هريرة وعن إخوانه من الصحابة رضي الله عنه؛ لجئوا إلى حيلة أخرى وهي الطعن في علماء المسلمين عامة؛ لأن الاختلاف وقع بينهم، والله عز وجل إنما أمر بالاتحاد ونبذ الفرقة وذمها.
فقالوا: الحق واحد، وما اختلفوا إلا لأنهم ليسوا على طريق الحق، وليسوا على طريق الاستقامة، ولو كانوا كذلك لما اختلفوا!
ولا شك أن هذه الشبهة في ظاهرها لا بد أن تدخل وتلتبس على أذهان وأفهام العامة من الناس، والعامة ليسوا أهل شبه، فمع أنهم القطاع العريض والعظيم في الأمة، لكنهم ليسوا مدار ثبوت الأحكام ونشرها، وإنما مدار ذلك على أهل العلم؛ لأنهم أصحاب العلم، وهم أهل الاجتهاد، وعليهم مدار الفتوى، فأولئك يريدون أن يشوشوا عقائد عامة المسلمين، وصغار طلاب العلم بصرفهم عن طريق السلف.
واجب أهل العلم تجاه المسالك الشيطانية لأهل البدع ضد الدين
والتوفيق بين تحذير أئمتنا لنا من أن نسمع كلام أهل البدع وبين تصديهم لهم: أنه لا يتصدى لهم إلا أهل العلم، ويحمل تحذيرهم لعامة الناس، ولمن يظن أنه يقع في حبائلهم، وأما أهل العلم الذين أوجب الله عز وجل عليهم إظهار هذه الشبهات، والرد عليها، وتفنيد مزاعم أهل الباطل؛ فهذا من أوجب الواجبات عليهم، ولذلك تجد في كل عصر من ينصح الأمة ويحذرها من أهل البدع، وهو بنفسه الذي يفضح ألاعيبهم، ويكشف عوارهم، ويبين فساد أقوالهم؛ لأن هذا يتعين عليه هو، وأما عامة أهل العلم مثلاً وعامة الناس فمن الخطورة بمكان أن يصغي أحدهم إلى أقوال أهل البدع.
وأهل البدع في كل زمان ومكان يتجملون ويتلطفون جداً مع العامة، ويظهرون من حسن الخلق الشيء الكثير حتى يغتر بهم العامة، ولا أدل على ذلك من أن النصارى -وهم النصارى وليس بعد الكفر ذنب- يتجملون جداً ويتلطفون، ويستخدمون أعلى أساليب الدهاء والمكر والخداع في استرضاء المسلمين، حتى إننا نجد جهلة المسلمين يلتقون بهم، ويصرحون أحياناً بأن النصارى أحسن من المسلمين، هكذا نسمع، وهذا ما هو إلا نقلة من مكائد أهل البدع، فيستخدمه أحدهم إذا أراد أن يعطيك شكوكاً، أو يوهمك في أصول الشريعة، أو يصرفك عن طريقك الذي تسلكه، فيصرفك بطريقة لبقة جداً مهذبة، وإن شئت فقل: بطريقة مقنعة لأهل الإيمان، مقنعة لمن كان قصده مبدأ لا عقيدة فيها ولا شريعة ولا فقه ولا علم.
فكلامهم لا يقبله إلا عقل فارغ ليس فيه شيء من دين الله عز وجل، وأما أن هذا الكلام مقنع أو مستقيم على الأصول الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح؛ فليس كذلك، فهذه هي الأصول التي بها نقبل وبها نرد الأخبار، فالإمام هنا يحذر من سماع كلام هؤلاء القوم.
الاختلاف الممدوح في فروع الشريعة لا في أصولها
فـمالك بن أنس رحمه الله إمام، وله أصحاب يعملون بقوله، ويعيبون من خالفه، وكذلك الشافعي ، وكذلك أبو حنيفة ، وكذلك أحمد بن حنبل ، كل واحد من هؤلاء له مذهب يذهب إليه وينصره].
لكنه يزيد فيقول: ويعيب من خالفه، ولم يثبت عن واحد من هؤلاء الأئمة أنه عادى من خالفه، لكن هذه الكلمة كالسم، وضعها لأجل أن تأخذها وتبني عليها الآمال في تساوي الاختلاف بين هؤلاء الأئمة، وبينهم وبين غيرهم من أهل البدع، فيقول: هذا اختلاف وذاك اختلاف، ولما وقع بين هؤلاء الخلاف فما المانع أن يقع بينهم مجتمعين وبين غيرهم ممن ينسبون إلى البدعة! فيهون بعد ذلك الخلاف الناجم بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع.
لذا لا بد أن تعلم أن الخلاف الذي وقع بين هؤلاء الأئمة إنما هو خلاف في الفروع لا في الأصول، فأصولهم في الاعتقاد والدين والشريعة واحدة، وإنما وقع الاختلاف بينهم في فروع الأحكام خاصة، وهذا الخلاف محل نظر عند العلماء، ولهم فيه مذهبان سنتعرض لهما في هذا الباب.
وأما أن يكون الاختلاف واقع بين هؤلاء الأئمة المتبوعين في أصول الدين والشريعة؛ فليس الأمر كذلك، فالذي يعاب على أهل البدع ليس هو اختلافهم فيما يتعلق بفروع الشريعة؛ لأنه من نوع اختلاف علماء المسلمين، وإنما الذي يعاب عليهم، واستوجبوا به النار خلافهم لكتاب الله عز وجل، ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإجماع المسلمين فيما يتعلق بأصول الدين لا بفروعه.
فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: (لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة) فالصحابة -وهم أعلم الناس بالخطاب النبوي، وبمراد النبي عليه الصلاة والسلام- لما لم يصلوا إلى بني قريظة حتى كاد وقت العصر أن يخرج ويدخل وقت المغرب؛ اختلفوا: فبعضهم قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك على سبيل الأمر والإلزام، وإنما من باب الخبر والبشارة أننا سندخل بني قريظة قبل صلاة المغرب.
وبعضهم قال: نلتزم ظاهر النص، فلا نصلي العصر إلا في بني قريظة وإن دخل وقت المغرب.
فالذي أخذ الأمر على ظاهره لم يصل العصر إلا في بني قريظة بعد دخول وقت المغرب، والذي اعتبر أن هذا الكلام ليس أمراً وإنما هو خبر والمراد البشارة؛ صلى العصر في آخر وقته، ثم إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنكر وعنف أحد الفريقين، وإنما أجاز هؤلاء على ما فهموه، وأجاز هؤلاء على ما فهموه.
وهذا يدل على أن الاختلاف جائز، وأن الاختلاف سائغ، وما وقع الاختلاف إلا لاختلاف عقول المجتهدين، أي: أن النص واحد والاجتهاد فيه متعدد، وكل اجتهاد في النص مقبول، فهؤلاء لما حملوا الأمر على ظاهره كان كلامهم مقبولاً لا يرده أحد، ولذلك لم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء لما فهموا فهماً آخر من النص، فهم لم يجتهدوا مع النص، وإنما وقع اجتهادهم في فهم النص، ولذلك فالاجتهاد عند أهل العلم نوعان: الاجتهاد مع وجود النص، والاجتهاد في فهم النص، فالثاني جائز؛ بل هو فرض كفاية، والأول باطل؛ لأنه لا اجتهاد مع النص.
والشاهد: أن هذا الخلاف مرده إلى أصل من الأصول وهي السنة، وإذا اختلف المجتهدان فالمصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد.
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عند مسلم من حديث أبي هريرة ، وعند البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)، فلم يجرمه ولم يؤثمه؛ لأنه إنما تعمد الحق واجتهد في الوصول إليه فأخطأ، فهو يأخذ أجر الاجتهاد وإرادة الحق.
وأما الأول فإنه أخذ نفس الأجر، وأجراً زائداً وهو إصابة الحق، والكل من عند الله عز وجل، فهذا أصاب من عند الله، وهذا لم يصب من عند الله بقدر كوني.
الرد على شبهة: أن الحق واحد وقد اختلف الأئمة
هذه المسألة محل نزاع بين أهل العلم: هل الحق في قضايا الخلاف واحد أم متعدد؟
ولا بد قبل الإجابة عن هذا السؤال أن نقول: الحق هذا ما المراد به: الحق في أصول الدين، أم في فروعه؟
فإذا قلنا: في أصول الدين؛ فلا بد أن يكون الجواب: الحق واحد في أصول الدين وأصول الشريعة، وإذا كان الجواب في فروع الشريعة وفي مسائل النزاع والاختلاف بين أهل العلم فأقول: الحق فيها يمكن أن يتعدد، بدليل ما ذكرت من إمكان الصلاة في بني قريظة، فلو كان الحق فيها واحداً لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الفريق الثاني الذي خالف، وهناك مئات الأمثلة في كتاب الله عز وجل، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سيرة الخلفاء الراشدين تشهد بذلك، وسيذكر بعضها الإمام.
قال ابن بطة مجيباً عن شبهة هذا الذي التبست عليه أقاويل أهل الزيغ والضلال: [فإني أقول له في جواب هذا السؤال: أما ما تحكيه عن أهل البدع مما يعيبون به أهل التوحيد والإثبات من الاختلاف؛ فإني قد تدبرت كلامهم في هذا المعنى، فإذا هم ليس الاختلاف يعيبون، ولا له يقصدون، وإنما هم قوم علموا أن أهل الملة وأهل الذمة والملوك والسوقة والخاصة والعامة وأهل الدنيا كافة إلى الفقهاء يرجعون، ولأمرهم يطيعون، وبحكمهم يقضون في كل ما أشكل عليهم، وفي كل ما يتنازعون فيه، فعلى فقهاء المسلمين يعولون، وفي رجوع الناس إلى فقهائهم، وطاعتهم لعلمائهم ثبات للدين].
أي: أن أهل الزيغ لما علموا أن عموم طبقات الأمة يرجعون إلى فقهائهم، ما كان منهم إلا أن سلكوا مسلك الطعن في الفقهاء الذين هم مرجع للأمة، وكأن لسان حالهم: لا بد أن أهدم وأصدع ذلك الجدار الذي تستند إليه، ولا بد أن ينهار هذا الجدار الذي تركن إليه، وليس بإمكانهم أن يطعنوا في الإسلام، لذلك طعنوا في فقهاء الأمة، حتى إذا انهارت مكانة العالم في نفسك وقلبك؛ فلا بد أن ينهار كل ما يأتي منه من فتوى وعلم، وتكليف وبيان وغير ذلك.
كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا كلام رائع جداً، وأروع منه أن تنزله من حياتك منزلة العمل لا منزلة الحفظ فقط، وهذه أصول درج عليها أهل السنة والجماعة منذ عهد الخلفاء الراشدين يستمر بإذن الله إلى قيام الساعة.
فالأمر هنا أن الطالب الذي ينظر إلى شيخه أنه القدوة والأسوة فإن سقط مرة سقط كله؛ أنا أنصح هذا الطالب نصيحة مشفق ألا يقرب من شيخه قط، وإنما يأخذ منه خيره في مجلس العلم، وأما أن يلزمه ويصاحبه ويذهب معه ويعود معه ويأكل ويشرب وينام ويسافر ويعود معه، فيرى منه ما يرى هو من نفسه، فيقول: لا فرق بيني وبينه! فيقع هذا الإنسان في قلبه ما لا ينتفع بعد ذلك به، فأنا أنصحه والحالة هذه: أن يلزم بيته، وأن يلزم مجلس العلم ولا يقترب من الشيخ إلا أن يصافحه وينصرف، ولو ترك مصافحته لكان أولى؛ حفاظاً على الانتفاع بهذا الشيخ دائماً.
العلة التي جعلت أهل الأهواء يتكلمون في الفقهاء والعلماء
وهذا كلام جميل، والذي يقع من بعض المشايخ من كلام بعضهم في بعض يكون التعامل معه بأن يؤخذ من كل شيخ أحسن ما عنده فقط، لأن الخطأ منهم وارد، لكن لا يمكن أن يكون ديدنه السباب والشتيمة؛ إذ لا يصبر على هذا الأذى من أي أحد فضلاً عن شيخ يتعامل مع كتاب الله، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أي: أنه قد يسب أحياناً، ويعلم الناس أحياناً، فخذ منه ما أصاب فيه من علم موافق للأصول، وخذ من الآخر العلم الذي وافق الأصول، وأما ما خالف الأصول فدعه، وعليك أن تصك أذنك عن سماع ما لا يليق بأهل العلم من سباب وغيره.
شؤم بعض الطلاب في نقلهم للأخبار والإفساد بين العلماء
فالسعيد من ترك غيره وانشغل بنفسه، وكرس حياته في حفظ كتاب الله تعالى، وفي حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرها.
هدف أهل البدع من طعنهم على فقهاء وعلماء المسلمين
فأما أهل البدع -يا أخي! رحمك الله- فإنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون ما يأتون، ويجحدون ما يعلمون، ويبصرون القذى في عيون غيرهم وعيونهم تطرف على الأجذاع.
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (يرى أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع أو الجذل في عينه)، فيرى أحدكم أقل الهفوات التي وقع فيها أخوه، ثم هو عنده من العيب كأصول النخل وأصول الشجر، لكنه لا يذكرها، فينسى ما عنده من عظائم ومن بلايا ويذكر هفوات أخيه، وكذلك أهل البدع ينظرون في فقهاء الملة وعلماء الشريعة إلى أقل الأخطاء، وينسون أنهم مخالفون لأصول الدين وأصول الشريعة، بل يتهمون أهل العدالة والأمانة في النقل، ولا يتهمون آراءهم وأهواءهم على الظن].
أي: أن الراوي يروي بيقين ومع هذا هو عند أهل الفرق مجتهد، وأهل البدع لا علاقة لهم بالنقل أصلاً، وإنما دينهم الرأي والنظر والظن والتخمين، فهم لا يرون هذه البلايا التي في أنفسهم، وإنما يتهمون الرواة مع أنهم أهل النقل.
بيان أن أهل البدع هم أكثر الناس اختلافاً واضطراباً
بينما الواحد من هذه الأمة عندما يخالف في مسألة من مسائل الأحكام فإننا نقول: يكفي أنه من أهل السنة، لكن لا نقره على الخطأ، ولا نبدعه ولا نفسقه، وإنما نقول: تأول في القضية الفلانية وخرج بها عن حد الاعتدال الذي عليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بفروع الأحكام، ولا نزيد على ذلك بلعنه ولا سبه ولا شتمه ولا تفسيقه وتبديعه فضلاً عن تكفيره، ولعلكم تذكرون أن الإمام الشافعي قال: الفرق بيننا وبين أهل البدع أن الواحد منهم إذا خالف صاحبه قال: كفرت، وإذا خالف أحدنا صاحبه قال: أخطأت.
فالمخطئ فينا مخطئ، ولا نزيد على ذلك، والمخطئ في أهل البدع مع بعضهم لبعض فاسق أو كافر، ولذلك قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: أهل السنة لأهل البدع أرحم من أهل البدع بعضهم لبعض؛ لأن الواحد منهم إذا خالف صاحبه قال: كفرت، والواحد منا إذا خالف صاحبه قال: أخطأت، إذاً فأهل السنة أرحم بأهل البدع من أهل البدع بعضهم ببعض، وهذا كلام في غاية الأهمية.
ولذلك ففي أهل البدع نوع شبه من قول الله عز وجل: ![]() وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ![]() [البقرة:113].
[البقرة:113].
اختلاف أهل البدع كاختلاف اليهود والنصارى وأهل الشرك
إذاً الاختلاف الذي ذكرناه الآن هو اختلاف في الأصول، وبالتالي من خالفنا في مثل هذا أو في بعضه استحق أن يكونوا من أهل الأهواء والبدع، وأما إذا خالفنا في مسألة تتعلق بالفروع الشريعة، أو بحكم من الأحكام العملية فلا يستحق عليه الوعيد بالنار، ولا يخرج من حد الاحتجاج.
الرافضة أشد الناس اختلافاً وتبايناً وتطاعناً
وأنا كنت أتصور أن هذا الكلام مبالغ فيه، لكن رأيت أن الشيعة كانت تكفر شاه إيران وهو ملكهم، ولم يكونوا يحجون إلى بيت الله الحرام، ولما تولى الخميني إيران أتت الأفواج بالملايين إلى مكة ليحجوا بيت الله الحرام، وأحدهم بل أكثر من واحد منهم صرح بأنه يعوض السنوات الماضية التي توقف فيها الجهاد والحج وصلاة الجمعة وغيرها مما يلزم فيها الإمام، فلما ظهر إمامهم رجعوا إلى العبادة التي توقفت على نزول الإمام، والمسلمون اليوم ليس لهم إمام، فهل يقول واحد منكم بتوقف صلاة الجمعة حتى يظهر الإمام أو خليفة عام للمسلمين أو المهدي المنتظر؟! وهل نعطل الجهاد مثلاً لعدم وجود الإمام أو الخليفة؟!
الجواب: لا، فالجهاد ماض إلى قيام الساعة في كل وقت إذا احتاج المسلمون إليه، والرافضة يقلدون أهل السنة في هذا الكلام.
قال: [وإنه من لا إمام له فلا دين له -هكذا يقولون-، ومن لم يعرف إمامه فلا دين له، ثم يختلفون في الأئمة، فالإمامية لها إمام تسوده -أي: تجعله سيداً عليها- وتلعن من قال: إن الإمام غيره بل وتكفره، وكذلك الزيدية لها إمام غير إمام الإمامية، وكذلك الإسماعيلية، وكذلك الكيسانية والبترية، وكل طائفة تنتحل مذهباً وإماماً، وتلعن من خالفها عليه بل وتكفره.
ولولا ما نؤثره من صيانة العلم الذي أعلى الله أمره، وشرف قدره ونزهه أن يخلط به نجاسات أهل الزيغ، وقبيح أقوالهم ومذاهبهم التي تقشعر الجلود من ذكرها، وتجزع النفوس من استماعها، وينزه العقلاء ألفاظهم وأسماعهم عن لفظها؛ لذكرت من ذلك ما فيه عبرة للمعتبرين، ولكنه قد روي عن طلحة بن مصرف رحمه الله أنه قال: لولا أني على طهارة لأخبرتكم بما تقوله الروافض]. وهذا الكلام خرج منه مخرج المبالغة في الإنكار على مقالات الرافضة والخوارج.
قال: [ويقول كذلك ابن المبارك : إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية]؛ لأن كلام الجهمية أشد قبحاً من كلام اليهود والنصارى، فكلام اليهود والنصارى رجس، وأما كلام الجهمية فهو أقبح من رجس.
قال: [ولولا أنك قلت: إن أهل الزيغ يطعنون على أئمتنا وعلمائنا وعلمائها باختلافهم، فأحببت أن أعلمك أن الذي أنكروه هم ابتدعوه، وأن الذي عابوه هم استحسنوه، ولولا اختلافهم في أصولهم وعقودهم وإيمانهم ودياناتهم لما دنسنا ألفاظنا بذكر حالهم].
أقسام الاختلاف
[فأما الاختلاف فهو ينقسم على وجهين]، تعرض لمسألة الاختلاف وأقسامه حتى يبين لك أن الاختلاف نوعان، في أصول الدين، وفي فروعه، أما اختلاف أئمتنا الذي دخل عليك كشبهة فقلت لـابن بطة : لم تعيب يـا ابن بطة على من تسميهم أهل الزيغ والأهواء لمجرد أنهم مخالفون لنا، مع أن الخلاف وقع في أئمتنا، فنحن نعيب عليهم ما وقعنا فيه، فـابن بطة يقول: لا، ليس هذا الكلام سليماً ولا صحيحاً، ومرد ذلك إلى معرفة نوع الاختلاف، وهو نوعان: اختلاف في العقائد والأصول، واختلاف في الفروع.
فأما الذي وقع فيه فقهاؤنا فهو الاختلاف في الفروع، وأما الذي وقع من أهل الزيغ والضلال فهو الاختلاف في الأصول، وإن اتفقا في مصطلح الاختلاف إلا أنه شتان ما بين الاختلاف الواقع بين فقهائنا في فروع الشريعة، وبين اختلاف فقهائنا وغيرهم من أهل الزيغ والضلال في أصول الشريعة وأصول الدين.
لكن أهل الزيغ لما أرادوا صرف القاعدة العامة عن فقهائها وعلمائها لم يذكروا هذه الأحكام، وإنما اكتفوا بما أسموه بالاختلاف، ونحن قد اختلفنا يا عامة الناس مع علمائكم، وهذا لا ينكر علينا؛ لأن فقهاءكم كذلك قد اختلفوا، فيلزمكم إذ تعيبوننا على هذا الخلاف أن تعيبوا أنفسكم، هكذا أراد أهل الزيغ أن يقولوا، وأن يلبسوا على عامة الناس فانتبهوا.
قال: [فأما الاختلاف فهو ينقسم على وجهين: أحدهما: اختلاف الإقرار به إيمان ورحمة وصواب، وهو الاختلاف المحمود الذي نطق به الكتاب، ومضت به السنة، ورضيت به الأمة، وذلك في الفروع والأحكام التي أصولها ترجع إلى الإجماع والائتلاف]. إذاً هذا هو الاختلاف المحمود الذي لا ينكر، وهو اختلاف علماء أهل السنة.
قال: [واختلاف هو كفر وفرقة وسخطة وعذاب، يئول بأهله إلى الشتات والتضاغن والتباين والعداوة واستحلال الدم والمال، وهو اختلاف أهل الزيغ في الأصول والاعتقاد والديانة.
فأما اختلاف أهل الزيغ فقد بينت لك كيف هو وفيما اختلفوا فيه، وأما اختلاف الشريعة الذي يئول بأهله إلى الإجماع والإلفة والتواصل والتراحم؛ فإن أهل الإثبات من أهل السنة يجمعون على الإقرار بالتوحيد، وبالرسالة، بأن الإيمان قول وعمل ونية، وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعلى أن الله خالق الخير والشر ومقدرهما، وعلى أن الله يرى في القيامة، وعلى أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله، وأن الله على عرشه بائن من خلقه، وعلمه محيط بالأشياء، وأن الله قديم لا بداية له ولا نهاية ولا غاية].
أي: ولا حد، واسم القديم قال بعضهم: ثبت هذا في بعض النصوص، لكن ثبوت هذا الاسم محل نظر عند المحققين، مع أنه قد استخدمه بعض من أبناء المسلمين، ولما كانت أسماء الله تعالى توقيفية كان ينبغي الوقوف عند ما صح في كتاب الله، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبإمكاننا أن نستخدم اسم الأول مكان القديم؛ لأنهم أرادوا بالقديم الأول، والأول ثابت بالتواتر في كتاب الله، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ندع ما ثبت بالتواتر وعليه إجماع المسلمين، وندخل في اسم آخر هو محل نزاع بين علماء المسلمين؟!
ولفظة (أول) أقوى في الدلالة من القديم؛ لأن القديم قبله أقدم، أما الأول فليس قبله شيء، وبالتالي فنكتفي بالوقوف عنده.
قال: [بصفاته التامة، لم يزل عالماً ناطقاً سميعاً بصيراً حياً حليماً، قد علم ما يكون قبل أن يكون، وأنه قدر المقادير قبل خلق الأشياء].
إجماع أهل السنة على خلافة الخلفاء الأربعة بالترتيب المعروف، واختلافهم في الأفضلية بين عثمان وعلي
وقوله: عليهم السلام، من جهة الاصطلاح (عليه السلام) خاصة بالأنبياء.
قال: [وعلى تقديم الشيخين]. أي: لم يختلف أحد من أهل السنة فيما يتعلق بإمامة الأربعة الخلفاء الراشدين، وكذلك أجمعوا على أن الأول منهم هو أبو بكر، ثم عمر ، والخلاف إنما وقع في الأفضلية لا في الإمامة بين عثمان وعلي ، فبعضهم قال: عثمان أفضل من علي ، وهؤلاء هم جمهور أهل السنة، وبعضهم قال: بل علي أفضل من عثمان .
وقيل: إن من قال ذلك فقد رجع عن هذا القول، لكن الشاهد: أن الإجماع انعقد على تقديم أبي بكر وعمر بغير خلاف، ووقع الخلاف -حتى وإن رجع بعد ذلك- في الأفضلية بين عثمان وعلي .
وهذا الخلاف في فرع من فروع الدين، وبالتالي فالمسألة تتعلق بالاعتقاد، إلا أن الخلاف فيها لا يبدع فيه صاحبها ولا يفسق.
بعض الإجماعات عند أهل السنة والجماعة
ثم أهل الجماعة مجمعون بعد ذلك على أن الصلاة خمس، وعلى أن الطهارة والغسل من الجنابة فرض، وعلى الصيام والزكاة والحج والجهاد، وعلى تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، والربا والزنا، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، وتحريم شهادة الزور، وأكل مال اليتيم، وما يطول الكتاب بشرحه.
فهم متفقون ومجمعون عليه؛ لأن هذا وإن كان متعلقاً بالشريعة لا بأصل الديانة، فهو أمر من أصول شرائعنا محل إجماع لم يخالف في ذلك أحد].
أي: لم يظهر في علماء المسلمين أو في علماء السنة من يقول مثلاً: الصلاة أربع فقط، ولو ظهر فلا بد أن ينتقل من أهل السنة إلى أهل البدعة فوراً؛ لأنه يقدح في الأصول، وليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هذا مذهب أهل البدع، فمنهم من قال: الصلاة اثنتان: واحدة في أول النهار، والأخرى في نهاية النهار، ومنهم من يقول: الصلاة ما هي إلا الدعاء، ولا صلاة قط وينشرون هذا ويقولونه، وبالتالي فلا صلاة قط عندهم، وهؤلاء بلا شك هم أهل الزيغ والضلال.
اختلاف أهل السنة لم يقدهم إلى الفرقة والشتات
والسنن الراتبة للفرائض الخمس: اثنتا عشرة ركعة، ومنهم من يقول: هي عشر ركعات، وهذا الاختلاف ناشئ من حديثين: أحدهما: حديث عبد الله بن عمر ، والثاني: حديث عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بسنة الظهر كم ركعات.
فمن قال بأن السنن الراتبة عشر اعتمد على حديث في الصحيحين، ومن قال: إنها اثنتا عشرة اعتمد على حديث في الصحيحين، فهل هذا الخلاف يفسق ويبدع به المخالف؟ لأنهما يردان إلى أصل واحد، وهو اعتبار ما ورد من اختلاف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهذه الجزئية.
قال: [ولم يعب بعضهم على بعضهم ذلك، ولا أكفره، ولا سبه ولا لعنه، ولقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام اختلافاً ظاهراً علمه بعضهم من بعض، وهم القدوة والأئمة والحجة، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إن الجد يرث ما يرثه الأب، ويحجب من يحجبه الأب، فخالفه على ذلك زيد بن ثابت ، وخالفهما علي بن أبي طالب ، وخالفهم ابن مسعود .
وخالف ابن عباس جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل من الفرائض، وكذلك اختلفوا في أبواب من العدة والطلاق، وفي الرهون والديون والوديعة والعارية، وفي المسائل التي المصيب فيها محمود مأجور، والمجتهد فيها برأيه المعتمد للحق إذا أخطأ فمأجور أيضاً غير مذموم؛ لأن خطأه لا يخرجه عن الملة، ولا يوجب له النار كما جاء ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران) الحديث].
كلام ابن بطة في اختلاف الفقهاء وأنواع الاختلاف غير المعتبر
أي: أنهم أجمعوا على وجوب غسل الوجه، فليس هناك أحد من علماء المسلمين قال: ليس غسل الوجه شرطاً في صحة الوضوء.
قال: [واختلافهم في المضمضة والاستنشاق، فبعضهم ألحقها بالفرائض، وألحقها الآخرون بالسنة].
إذاً ستقول: إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد أمر بوجوب غسل الوجه، فلم وقع الخلاف إذاً؟
والجواب: أن هذا اختلاف في الأفهام للنص، فلو كان هناك واحد فهم النص فهماً بعيداً جداً لا يمكن أن يحتمله النص؛ فسنقول: هذا الفهم خطأ، ولا يمكن أبداً أن يساعده الدليل، فاستنباطه للنص بهذا الفهم خطأ؛ لأن النص لا ظاهراً ولا باطناً يشهد له، لكن لو كان الاجتهاد يحتمله النص، فحينئذ يكون هذا الخلاف معتبراً، والخلاف المعتبر لا إنكار على المخالف فيه، وإنما ينكر على الخلاف غير المعتبر.
وهو وجهان:
الوجه الأول: أنه خلاف مع النص، أو خلاف ضد النص.
والوجه الثاني: أنه خلاف لا يحتمله النص.
فبعد أن أجمع علماء المسلمين على وجوب غسل الوجه في الوضوء؛ اختلفوا في المضمضة والاستنشاق:
فبعضهم قال: المراد: ظاهر الوجه دون باطنه، ثم اختلفوا: هل باطن الأنف وباطن الفم من الوجه أم من غير الوجه؟
واعلم أن العلماء لم يختلفوا على جواز المضمضة والاستنشاق، وإنما اختلفوا في التكليف الشرعي للأمر هل هو الوجوب أم الاستحباب؟
فبعضهم قال: المضمضة والاستنشاق مستحبان؛ لأنهما ليسا من الوجه، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية قد بينت أنه كان يتمضمض ويستنشق، لكن لم يرد أن ذلك كان على سبيل الإلزام والحث، فيبقى الأمر على الاستحباب.
وبعضهم قال: المضمضة والاستنشاق واجبان، أي: أن الأنف والفم باطنهما من الوجه، ومما يؤيد ذلك استمراره عليه الصلاة والسلام على المضمضة والاستنشاق، ولو لم يكونا من الوجه لتركهما النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة.
فالكلام الأول وجيه لا نرده، والكلام الثاني أوجه، وهو الذي يحتمله النص احتمالاً ظاهراً.
لكني أريد أن أقول: إن الخلاف في أن المضمضة والاستنشاق ليسا من الوجه اختلاف يحتمله النص، ولذلك وقع الاختلاف بينهم بعد أن أجمعوا على وجوب غسل الوجه.
قال: [وإجماعهم على المسح على الخفين، وهذه مسألة من المسائل العلمية، وقد دخلت في مسائل الاعتقاد لمخالفة فرقة من فرق الضلالة لأهل السنة والجماعة، ثم صارت علماً على فرقة من فرق الضلال وهي الشيعة.
ولما اتخذتها الشيعة ديناً لهم كان لزاماً الرد عليها من قبل أهل السنة والجماعة، إذ إنها من مسائل الاعتقاد ومن مسائل العمل في آن واحد.
والإجماع حاصل عند أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين، لكن الاختلاف وقع في كيفية المسح: هل المسح على ظهر الخف فقط، أم على ظاهره وباطنه؟
والراجح في هذه المسألة: هو المسح على ظاهر الخف؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى؛ لأنه مماس بالأرض أو بالنجاسة أو ما يمكن أن يكون كذلك.
وأما الذين قالوا: المسح على ظاهر الخف وباطنه، فربما لم يبلغهم ذلك، أو ربما قالوا بالمسح على باطن الخف من باب الاحتياط والاحتراز، مع علمهم بحديث علي بن أبي طالب ، وربما قالوا بالظاهر والباطن جمعاً بين الرأيين.
ثم اختلف القائلون بالمسح على ظاهر الخف وباطنه في الكيفية، فبعضهم قال: الماسح يضع كفيه في الماء فيضع مؤخرة كفه عند أطراف أصابعه من فوق، ويده اليسرى في باطن كفه على هذا النحو والنسق، ثم يجريهما حتى يرتفع بها. ورأي آخر عندهم يقول: إنما يضع طرف أصابع يده اليمنى على أطراف أصابع رجله، وأما يده اليسرى فتكون من فوق الكعبين، ويمشي بهما على شبه دائرة، يعني: يضع أطراف أصابعه على قدمه هكذا ويده الشمال في مؤخرة القدم، ويأتي بهما هكذا مسحاً.
وبإمكاننا أن نقول في هذه القضية: خطأ وصواب؛ لأن الاختلاف إما معتبر، أي: راجح ومرجوح، وإما خطأ وصواب، لكن العذر أن المخطئ قوله مرجوح لموافقته للأصول، وما وقع منه الاختلاف إلا في فرع من الفروع التي لا يبدع بها ولا يتهم.
اختلاف داود وسليمان في الحكم
يعني: واحد عنده زرع، وآخر عنده غنم، فوقعت الغنم في الزرع، فعرض الأمر على داود وسليمان، ![]() فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ![]() [الأنبياء:79] يعني: أن سليمان -وهو ابن داود- أصاب أكثر من أبيه في هذه القضية؛ لأن داود عليه السلام حكم فيها بحكم وهو أنه حكم بالغنم لصاحب الحرث؛ عقوبة لصاحب الغنم، فلما تركوا داود مروا على سليمان فأخبروه بما قضى به أبوه، فقال: لي قضاء يخالفه، وذهب بهم إلى والده -وكلاهما نبي من أنبياء الله- فقال: بلغني أنك قضيت في أمر هؤلاء بكيت وكيت، قال: نعم، قال: ولكني أقضي فيها بخلاف ما قضيت، أقضي أن يأخذ صاحب الحرث الغنم ينتفع بأصوافها وأوبارها وألبانها، ويأخذ أصحاب الغنم الحرث حتى ينبت ويصير كما كان قبل أن تنفش فيه الغنم، فإذا كان كذلك أخذ صاحب الحرث حرثه، وأخذ صاحب الغنم غنمه.
[الأنبياء:79] يعني: أن سليمان -وهو ابن داود- أصاب أكثر من أبيه في هذه القضية؛ لأن داود عليه السلام حكم فيها بحكم وهو أنه حكم بالغنم لصاحب الحرث؛ عقوبة لصاحب الغنم، فلما تركوا داود مروا على سليمان فأخبروه بما قضى به أبوه، فقال: لي قضاء يخالفه، وذهب بهم إلى والده -وكلاهما نبي من أنبياء الله- فقال: بلغني أنك قضيت في أمر هؤلاء بكيت وكيت، قال: نعم، قال: ولكني أقضي فيها بخلاف ما قضيت، أقضي أن يأخذ صاحب الحرث الغنم ينتفع بأصوافها وأوبارها وألبانها، ويأخذ أصحاب الغنم الحرث حتى ينبت ويصير كما كان قبل أن تنفش فيه الغنم، فإذا كان كذلك أخذ صاحب الحرث حرثه، وأخذ صاحب الغنم غنمه.
فأثنى الله تعالى على هذا القضاء فقال: ![]() فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ![]() أي: سليمان وداود
أي: سليمان وداود ![]() آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا
آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ![]() ، ولم يقل: أخطأ داود، وإنما لما أراد داود أن يصل إلى الحق فأخطأ أثنى عليه، ولم ينف عنه العلم والحكمة، وإنما أثبتهما له، مع أن سليمان أعلم وأفهم وأحكم منه.
، ولم يقل: أخطأ داود، وإنما لما أراد داود أن يصل إلى الحق فأخطأ أثنى عليه، ولم ينف عنه العلم والحكمة، وإنما أثبتهما له، مع أن سليمان أعلم وأفهم وأحكم منه.
ولقد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمثل اختلافهما في نحو هذه القضية، فعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (بينما امرأتان معهما ابناهما، إذ جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت كل واحدة لصاحبتها: إنّما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى) فهذه نفس القضية، والقضاء هنا لداود عليه السلام، فتعجل القضاء فقضى به للكبرى، (فمرتا على سليمان بن داود فقصتا عليه القصة، فقال: ائتوني بالسكين أشقّه بينهما) فهذا القضاء إنما احتمله ذكاء سليمان عليه السلام، إذ إنه في الحقيقة لا يريد أن يشقه؛ لأنه ذلك لا يصح؛ لأنه إن شقه مات، وكان قاتلاً لنفس بغير نفس.
قال: (فقالت الصغرى: يرحمك الله! هو ابنها)، ولا يمكن أن تقول المرأة هذا إلا إذا كان ولدها، فلئن يتربى في حجر غيرها خير من أن يموت، قال: (فقضى به لها)؛ لعلمه أنها أمه.
قال أبو هريرة : فوالله ما سمعت بالسكين إلا يومئذ، وكنا نقول: المدية.
قال: [فهذا رحمك الله! اختلاف الأنبياء عليهم السلام في الأحكام نطق به الكتاب، وجاءت به السنة، فماذا عسى أن يقوله أهل البدع في اختلافهم؟!].
الخلاف بين الصحابة والتابعين
وهنا كلام كبير جداً ذكره الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم، حيث إنه ذكر باباً عظيماً جداً وهو الباب الرابع والخمسون فقال: جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف الفقهاء.
وذكر بعد هذا الباب مباشرة: باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب، وأنه يلزم طلب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضاً، وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم.
وكأنه يريد أن يقول: إن الخلاف بين الفقهاء ليس على نسق واحد، وهم كذلك موقفهم من الخلاف ليس واحداً، بل هم أصحاب مذاهب، وهما المذهبان السابقان، فبعضهم يقول: الحق واحد لا يتعدد، ولا بد أن يصحح أحد الرأيين ويخطأ الرأي الثاني.
وبعضهم يقول: بل الخلاف راجح ومرجوح.
والشاهد من هذين البابين أنه ذكر الأدلة الكثيرة التي لا ترد على أن الخلاف أحياناً يكون معتبراً بقسميه، ويكون الأمر فيه راجحاً ومرجوحاً.
ومعنى ذلك: أن الخلاف صواب فيما يتعلق بوقوعه في بعض المسائل كما ضربت لكم مثلاً بالصلاة ببني قريظة، إذ لو كان أحد الاجتهادين خطأ لما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولبينه؛ لأن الأمر لا يحتمل التأخير في البيان، فلما سكت دل على أن ما وقع منهما مع الاختلاف كله صواب، وعليه فيجوز تعدد الحق.
وبعضهم قال: الحق واحد، ولا بد من الذهاب إلى أحد الرأيين ورد الثاني، واستشهد بمسائل قد اختلف فيها أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وأنكر بعضهم على بعض.
فهذه الأدلة فعلاً أخطأ فيها المخالف، وإني لا أسرد نفس الأدلة بعد أن أحلتك إلى الباب الرابع والخمسين والباب الخامس والخمسين من جامع بيان العلم وفضله، وإن ذهبت إلى هناك وقرأت هذين البابين لوجدت علماً غزيراً جداً.
قال: [اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعلا يتذاكران العلم، فجعل عمر ربما جاء بالشيء يخالف به القاسم، فجعل ذلك يشق على القاسم، فتبين ذلك لـعمر -أي: علم عمر أن حججه قوية، فربما شق ذلك على القاسم وغضب وتغير- فقال له عمر : لا تفعل فما أحب أن لي باختلافهم حمر النعم].
أي: أن اختلاف الصحابة إجمالاً أحب إلي من حمر النعم؛ لأن عمر يرى أن اختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رحمة.
قال: [وقال المعلى بن إسماعيل : ربما اختلف الفقهاء وكلا الفريقين مصيب في مقالته].
فاختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان مبناه على فهم الدليل فلا شك أنه رحمة، أما إذا كان أحدهما فهم فهماً خالف فيه الدليل ظاهراً وباطناً فلا شك أنها ليست رحمة، بل لا بد من ثبوت خطئه، وأيضاً لو قرأت البابين اللذين أحلتك إليهما لوجدت أدلة ذلك.
قال: [وقال أبو عون : ربما اختلف الناس في الأمر وكلاهما له الحق].
-
اختلاف الفقهاء يقال فيه: أخطأت، لا كفرت
اختلاف الفقهاء يقال فيه: أخطأت، لا كفرت
إذاً يقال للمخالف: أخطأت، إذا خالف مسألة مجمع عليها، ولا شك أن مخالفة الكتاب والسنة أولى في تخطئته من مخالفته للإجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بدليل أو أمارة من الكتاب والسنة، وحينئذ لو خالف الكتاب والسنة فإثبات خطؤه أولى من مخالفته للإجماع، وفي كل قد أخطأ.
والصورة الثانية من صور الخلاف: لو أن العلماء اختلفوا في الرأي اختلافاً مسوغاً فهل يقال في هذا الخلاف: إنه ليس برحمة؟ لا، بل هو رحمة، وهو خلاف رأي.
ولذلك إذا اعتقدت أن الخلاف صواب وخطأ؛ فلا بد أنك ستقف في كل يوم على عشرات المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم، ويترجح لديك اليوم ما تبطله أنت غداً، فمثلاً: مسألة: هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية أم لا؟ فمنهم من يعتقد وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، ومنهم من يعتقد أن قراءة الإمام لهم قراءة، فهذا الخلاف ليس مرده إلى الهوى، وإنما إلى الدليل، فإذا كان مرد الخلاف إلى فهم الدليل فلا يقال للمخالف فيما ذهب إليه: أخطأت، وإنما كل واحد يلزمه العبادة بما ترجح لديه إن كان طالب علم.
فأنت باعتبارك طالب علم لك نظر وبصيرة في الدليل، وقد أتيت بأصل المسألة وأدلتها، ونظرت في أقوال الفقهاء فترجح لديك وجوب القراءة، فلا يسعك بعد أن ترجح لديك وجوب قراءة الفاتحة أن تترك القراءة خلف الإمام، بل تبطل صلاتك لتركك ركناً متعمداً، وإن ترجح لديك بالدليل أن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم فلا يسعك القراءة، فإن قرأت فهو سنة بلا شك، لكن لو أنك تركت القراءة لاعتقادك أن قراءة الإمام تحل محل قراءتك لا تبطل صلاتك.
فلو أن اثنين يقفون في الصف، أحدهما: يعتقد الوجوب، والثاني: يعتقد عدم الوجوب، وكلاهما أدرك الإمام على حال معين، فهذا يقوم ويأتي بركعة، وذاك لا يأتي بركعة، وهذا هو خلاف الاجتهاد الذي بني على دليل واحد، أو على أدلة معناها واحد؛ لأنك طالب علم، فلا يسعك أن تقلد، بل لا تبرأ ذمتك إلا بالنظر في الدليل، والعمل بما ترجح لديك، وهو دين الله تعالى في حقك.
وأما العامي الذي ليس له نظر، ولا يعرف فهم الدليل؛ فهذا يلزمه بل يجب عليه تقليد مفتيه إذا غلب على ظنه أن هذا المفتي مستقيم، أي: إذا غلب على ظنه أن هذا الرجل صاحب صلاح ودين وعلم،فالعامي لا يعرف ما هو الدليل، ولا من أين أتى الشيخ بهذا الكلام، ولا كيف ترجح لك هذا، فهو عامي لا يعرف شيئاً، فهو يقلد هذا المفتي.
ولذلك انظر إلى الخليفة لما أرسل إلى الإمام مالك وقال له: مر طلابك أن ينسخوا من الموطأ نسخاً حتى أرسل بها إلى الأمصار؛ ليعملوا بها، قال: لا تفعل يا إمام المسلمين! فإنهم قد بلغهم من العلم ما لم يبلغنا، وبلغنا ما لم يبلغهم. فدل هذا على أن كلاً يعمل بما بلغه.
والعلماء قالوا: إن هذه من أعظم مناقب الإمام مالك ، وليست منقبة عادية، إذ إن الإمام مالك يسمح بوقوع الاختلاف في الفروع من هنا وهناك، وأن كلاً يعمل بما بلغه من علم.
قال موسى الجهني : كان إذا ذكر عند طلحة الاختلاف قال: لا تقولوا: الاختلاف، ولكن قولوا: السعة.
أي: أن الاختلاف يقع من الفقهاء، وهو باب من أبواب السعة، وباب من أبواب الرحمة.
قال الشيخ: [فالإصابة في الجماعة توفيق ورضوان، والخطأ في الاجتهاد عفو وغفران، وأهل الأهواء اختلفوا في الله، وفي الكيفية، وفي الأبنية -أي: مباني الإسلام الخمسة- وفي الصفات، وفي الأسماء، وفي القرآن، وفي قدرة الله، وفي عظمة الله، وفي علم الله، تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً].
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
 الأكثر استماعا لهذا الشهر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
-
39268
البوم روائع القصائد
عبد الواحد المغربي -
21909
أناشيد رمضانية منوعة
(...) -
19308
الرقية الشرعية - مشاري راشد العفاسي
-
15086
الشاطبية
الشيخ:عبد الرشيد بن الشيخ علي صوفي -
13800
قصص الأنبياء - قصة أيوب وذوالكفل- قصةأصحاب الرس- قصةذوالنون- قصة شعيب- قصةاهل القرية
طارق السويدان -
11448
منظومة عشرة الإخوان
توفيق سعيد الصائغ -
11285
أذان بصوت الشيخ ناصر القطامي
ناصر القطامي -
10850
الدرس الأول
سمير مصطفى فرج -
10270
هزتني
محمد المطري -
8189
مختارات لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
أبو علي

عدد مرات الاستماع
3087861306

 القرآن الكريم
القرآن الكريم علماء ودعاة
علماء ودعاة القراءات العشر
القراءات العشر الشجرة العلمية
الشجرة العلمية البث المباشر
البث المباشر شارك بملفاتك
شارك بملفاتك
 البث المباشر
البث المباشر