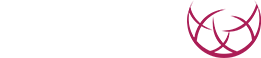الصوتيات
الصوتيات
- الصوتيات
- علماء ودعاة
- محاضرات مفرغة
- مساعد الطيار
- عرض كتاب الإتقان
- عرض كتاب الإتقان (51) - النوع الحادي والخمسون في وجوه مخاطباته
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين.
أما بعد:
فهذا النوع وهو ما يتعلق بوجوه المخاطبات وما سيأتي بعده مرتبط بعلم البلاغة، ولهذا يمكن أن تلاحظ نوعاً من الوحدة الموضوعية في ترتيب هذه المباحث، فمن هذا النوع تبتدئ الأنواع المرتبطة بالبلاغة، والأنواع السابقة الأولى كانت مرتبطة بالعلوم الخاصة المنبثقة من القرآن، ثم انتقل إلى العلوم التي لها ارتباط بأصول الفقه، وهنا انتقل إلى العلوم التي لها ارتباط بعلم البلاغة.
المراد بمخاطبات القرآن
لم يبين السيوطي رحمه الله تعالى المراد بالمخاطبات، ولكن الظاهر من خلال ما طرحه أن المراد به الخطاب العام، وليس المراد بالمخاطبة التي هي مرادفة للنداء أو المقاولة، أن نقول: قال كذا ثم رد عليه، وإنما المراد بها عموم الخطاب القرآني.
والبحث في عموم الخطاب القرآني واسع جداً، وهو مبحث نفيس جداً لمن أراد أن يفرّع عليه بحوثاً من البحوث العلمية سواء في رسائل ماجستير أو رسائل الدكتوراه، فلو تأملنا ما طرحه قال: قال ابن الجوزي في كتاب النفيس: الخطاب في القرآن على خمسة عشر وجها.
وهنا لم يذكر كتباً مرتبطة بالخطاب أو بالمخاطبات في القرآن مما يدل على أنه ليس عنده في هذا تأليف مستقل لأحد من العلماء، وإنما تجد هذا مبثوثاً في كتب العلماء، مثل الكتاب الذي ذكره هنا، ومثل مجاز القرآن لـأبي عبيدة معمر بن المثنى ، وكذلك المدخل إلى تفسير كتاب الله للحدادي ، وغيرها من الكتب التي تجد فيها إشارات إلى هذا النوع وهو خطابات القرآن.
ثم ذكر عن عالم آخر أنه قال: إن خطابات القرآن على أكثر من ثلاثين وجهاً، ثم بدأ يفصل في هذه الخطابات.
الخطاب العام المراد به العموم
ذكر منها الخطاب العام والمراد به العموم، ولو تأملناه فسيرجع إلى مسألة أصول الفقه من جهة، وهو مرتبط بنوع الخطاب من جهة أخرى، مثل قوله سبحانه وتعالى: ![]() اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ![]() [الروم:40] فهذا عام غير مخصوص؛ لأن كل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق.
[الروم:40] فهذا عام غير مخصوص؛ لأن كل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق.
الخطاب الخاص المراد به الخصوص
والنوع الثاني: الخطاب الخاص والمراد به الخصوص، وهو مقابل للعام المراد به العموم.
وذكر مثالاً له: ![]() يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ![]() [المائدة:67] فالخطاب بقوله:
[المائدة:67] فالخطاب بقوله: ![]() يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ![]() [المائدة:67] خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل العموم، وسيأتي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتمل غيره، وهذا راجع إلى القرينة، لكن قوله:
[المائدة:67] خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل العموم، وسيأتي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتمل غيره، وهذا راجع إلى القرينة، لكن قوله: ![]() يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ![]() [المائدة:67] هذا خطاب خاص والمراد به الخصوص.
[المائدة:67] هذا خطاب خاص والمراد به الخصوص.
الخطاب العام المراد به الخصوص
النوع الثالث: الخطاب العام والمراد به الخصوص، وهذا مهم جداً وسبق التنبيه عليه: وهو أن يكون الخطاب عاماً ويراد به الخصوص.
وذكر له مثالاً في قوله: ![]() يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ![]() [الحج:1]، وأخرج من هذا الخطاب العام في الناس بدلالة العقل الأطفال والمجانين؛ لأن الطفل لا يدخل في الخطاب بالأمر بالتقوى وكذلك المجانين، ولو مثّل بغيره لكان جيداً، مثل قوله سبحانه وتعالى:
[الحج:1]، وأخرج من هذا الخطاب العام في الناس بدلالة العقل الأطفال والمجانين؛ لأن الطفل لا يدخل في الخطاب بالأمر بالتقوى وكذلك المجانين، ولو مثّل بغيره لكان جيداً، مثل قوله سبحانه وتعالى: ![]() الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ![]() [آل عمران:173] فالناس في الموطنين عام أريد به الخصوص.
[آل عمران:173] فالناس في الموطنين عام أريد به الخصوص.
أما الناس في قوله: ![]() الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ![]() [آل عمران:173] فالمراد به نعيم بن مسعود الثقفي ، فلفظ الناس عام، والمراد به شخص واحد.
[آل عمران:173] فالمراد به نعيم بن مسعود الثقفي ، فلفظ الناس عام، والمراد به شخص واحد. ![]() إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ![]() [آل عمران:173] أيضاً لفظ عام والمراد به طائفة من قريش، وليس كل قريش، وإنما هم الذين خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فهم ليسوا كل قريش، ثم إنهم ليسوا كل الناس.
[آل عمران:173] أيضاً لفظ عام والمراد به طائفة من قريش، وليس كل قريش، وإنما هم الذين خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فهم ليسوا كل قريش، ثم إنهم ليسوا كل الناس.
إذاً: صار هذا الخطاب عام ويراد به الخصوص، وهذه المباحث الثلاثة محل بحث جيد، وأمثلة القرآن فيها كثيرة جداً.
فالعام المراد به العموم، والعام والمراد به الخصوص، والخاص والمراد به الخصوص.
فائدة الخاص المراد به الخصوص سيأتي مثل قوله سبحانه وتعالى: ![]() يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ ![]() [الأحزاب:1] هل هو خاص أريد به الخصوص، أو خاص ثم يعم غير النبي صلى الله عليه وسلم؟
[الأحزاب:1] هل هو خاص أريد به الخصوص، أو خاص ثم يعم غير النبي صلى الله عليه وسلم؟
الخطاب الخاص المراد به العموم
ذكر الرابع وهو: الخاص المراد به العموم، وأشار إلى قوله سبحانه وتعالى: ![]() يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ![]() [الطلاق:1].
[الطلاق:1].
فإذا تأملت في هذا السياق: ![]() إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ![]() [الطلاق:1] فإنه جاء بصيغة الجمع، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس وحده الذي يطلق النساء، وإنما يطلق المؤمنون أيضاً، فصار خطاباً خاصاً والمراد به العموم.
[الطلاق:1] فإنه جاء بصيغة الجمع، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس وحده الذي يطلق النساء، وإنما يطلق المؤمنون أيضاً، فصار خطاباً خاصاً والمراد به العموم.
إذاً: صار عندنا أربعة أنواع في قضية الخصوص والعموم: عام يراد به العموم، وعام يراد به الخصوص، وخاص يراد به الخصوص، وخاص يراد به العموم. وهذه كما قلنا محل بحث، وأمثلتها كثيرة في القرآن.
وأما قوله: ![]() يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ![]() [الأحزاب:50] فهذا خاص يراد به الخصوص؛ لأن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
[الأحزاب:50] فهذا خاص يراد به الخصوص؛ لأن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي قوله: ![]() يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ![]() [الطلاق:1] خاصٌ يراد به العموم، ويكون في الخاص الذي يراد به العموم تشريف للأمة بالابتداء بالخطاب إلى نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم تعميم الخطاب إلى أمته.
[الطلاق:1] خاصٌ يراد به العموم، ويكون في الخاص الذي يراد به العموم تشريف للأمة بالابتداء بالخطاب إلى نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم تعميم الخطاب إلى أمته.
خطاب الجنس والنوع والعين
ثم ذكر الأنواع الأخرى مثل: خطاب الجنس مثل قوله: ![]() يَا أَيُّهَا النَّاسُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ![]() [البقرة:21]. أو خطاب النوع نحو:
[البقرة:21]. أو خطاب النوع نحو: ![]() يَا بَنِي إِسْرائيلَ
يَا بَنِي إِسْرائيلَ ![]() [البقرة:40]؛ لأنهم نوع من الناس، أي: أقل من الناس؛ لأن الناس أعم.
[البقرة:40]؛ لأنهم نوع من الناس، أي: أقل من الناس؛ لأن الناس أعم.
أو خطاب العين مثل: ![]() يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ![]() [الأعراف:19] أو:
[الأعراف:19] أو: ![]() يَا نُوحُ
يَا نُوحُ ![]() [هود:48]،
[هود:48]، ![]() يَا إِبْرَاهِيمُ
يَا إِبْرَاهِيمُ ![]() [الصافات:104].. فهذه الخطابات الثلاث إذا تأملناها سنلاحظ أنها مرتبطة بالجنس وهو أعم والنوع أقل، ثم العين وهو أقل منها.
[الصافات:104].. فهذه الخطابات الثلاث إذا تأملناها سنلاحظ أنها مرتبطة بالجنس وهو أعم والنوع أقل، ثم العين وهو أقل منها.
ثم قال هناك فائدة في خطاب العين: إنه لم يقع في القرآن الخطاب بـ(يا محمد)، وإنما وقع ![]() يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ![]() [الممتحنة:12] و
[الممتحنة:12] و![]() يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ![]() [المائدة:41].
[المائدة:41].
وذكر الفائدة بأن هذا تعظيماً له وتشريفاً، وتخصيصاً بذلك عما سواه، وتعليماً للمؤمنين ألا ينادوه باسمه.
فمن باب تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لم يقع الخطاب له في القرآن بـ(يا محمد)، بخلاف غيره من الأنبياء حتى أشرف الأنبياء بعده وهو إبراهيم عليه السلام وقع الخطاب له بـ(يا إبراهيم)، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع له هذا الخطاب من باب التشريف والتعظيم له صلى الله عليه وسلم.
ومن باب الفائدة استطراداً: فإن القرآن لم يذكر محمداً صلى الله عليه وسلم إلا في مواضع قليلة جداً، يعني: أربعة أو خمسة مواضع، أما غيره من الأنبياء خصوصاً موسى عليه السلام فقد وقع ذكر موسى عليه السلام بالمئات، أو إبراهيم عليه السلام، أو عيسى عليه السلام، فذكرت أسماؤهم كثير ولم يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم إلا في مواطن قليلة، والاحتجاج العقلي الذي يبنى على هذا: أن القرآن لو كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم لأكثر من ذكر اسمه من باب التنويه باسمه، وكذلك لو كان من عنده صلى الله عليه وسلم لأظهر محاسنه وأخفى ما كان عنده من المعاتبات التي عاتبه ربه سبحانه وتعالى بها في مثل قوله سبحانه وتعالى: ![]() عَفَا اللَّهُ عَنْكَ
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ![]() [التوبة:43]، وقوله سبحانه وتعالى:
[التوبة:43]، وقوله سبحانه وتعالى: ![]() يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ![]() [التحريم:1].. وأمثال هذا، هذا من باب الفائدة استطراداً عندما ذكر أنه لم يقع الخطاب بـ(يا محمد).
[التحريم:1].. وأمثال هذا، هذا من باب الفائدة استطراداً عندما ذكر أنه لم يقع الخطاب بـ(يا محمد).
بعض الخطابات الأخرى في القرآن
ثم ذكر خطابات متعددة وسيكمل فيها إلى اثنين وعشرين خطاباً، لكن نأخذ بعض الخطابات.
فمن الخطابات ما يتعلق بقضية الجمع والإفراد والتثنية، وذكر فيها مجموعة من أنواع الخطابات، وهذه مذكورة في بعض الكتب مثل كتاب المدخل إلى تفسير كتاب الله للحدادي ، وكذلك في مقدمة أبي عبيدة معمر بن المثنى لكتابه مجاز القرآن، وكذلك تأويل مشكل القرآن لـابن قتيبة فقد عالجوا هذه الأنواع من الخطابات.
فخطاب الجمع بلفظ الواحد في مثل قوله: ![]() يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ![]() [الانفطار:6]، فالإنسان مفرد ولكن المراد به الجمع، كأنه جنس الإنسان.
[الانفطار:6]، فالإنسان مفرد ولكن المراد به الجمع، كأنه جنس الإنسان.
أما خطاب الواحد بلفظ الجمع، ففي مثل قوله سبحانه وتعالى: ![]() يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ ![]() [المؤمنون:51] على أن المراد به خطاب النبي صلى الله عليه وسلم.
[المؤمنون:51] على أن المراد به خطاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضاً ![]() وَإِنْ عَاقَبْتُمْ
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ ![]() [النحل:126] على قول: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يقع خطاب الواحد بلفظ الجمع.
[النحل:126] على قول: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يقع خطاب الواحد بلفظ الجمع.
وأيضاً خطاب الواحد بلفظ الاثنين وهذا على قول في قوله: ![]() أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ
أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ ![]() [ق:24] والمراد به مالك خازن النار على قول في التفسير، فيكون من باب خطاب الواحد بلفظ الاثنين. أي: هو خطاب مثنى والمراد واحد.
[ق:24] والمراد به مالك خازن النار على قول في التفسير، فيكون من باب خطاب الواحد بلفظ الاثنين. أي: هو خطاب مثنى والمراد واحد.
كذلك أورد قوله سبحانه وتعالى على رأي المهدوي قال: ![]() قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا
قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا ![]() [يونس:89] على أن المراد به موسى عليه السلام وحده، وإن كان الصحيح أن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، فجاءت التثنية على بابها.
[يونس:89] على أن المراد به موسى عليه السلام وحده، وإن كان الصحيح أن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، فجاءت التثنية على بابها.
أما خطاب الاثنين بلفظ الواحد كقوله: ![]() فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى
فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ![]() [طه:49]، وهذا على وجه، وإلا الصواب أن ربكما يعود إلى هارون وموسى، ثم وجه الخطاب بعدها إلى موسى عليه السلام، وذكر نكتاً في هذا الخطاب فقال: إنه أفرده بالنداء لإدلاله عليه بالتربية في قوله:
[طه:49]، وهذا على وجه، وإلا الصواب أن ربكما يعود إلى هارون وموسى، ثم وجه الخطاب بعدها إلى موسى عليه السلام، وذكر نكتاً في هذا الخطاب فقال: إنه أفرده بالنداء لإدلاله عليه بالتربية في قوله: ![]() أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ
أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ![]() [الشعراء:18]، فكأنه إدلال على موسى بالتربية أنه رُبّي في بيت فرعون، فخصه بالخطاب. هذا قول.
[الشعراء:18]، فكأنه إدلال على موسى بالتربية أنه رُبّي في بيت فرعون، فخصه بالخطاب. هذا قول.
أو: لأنه صاحب الرسالة وهارون عليه السلام كان فرعاً عنه، صحيح أنه نبي لكنه فرع عن رسالة موسى عليه السلام.
أو وجه آخر: أنه وجه الخطاب لموسى قصداً؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان كما هو معلوم فيه عقدة في لسانه، أي: كان فيه ثقل في لسانه، فكأنه أراد أن يوجه إليه الخطاب ليعييه في الجواب، وترك الخطاب لهارون لأنه أفصح. وهذا أقلها وأضعفها في الأجوبة، والأجوبة المذكورة قبل ألطف من هذا الجواب.
وذكر أمثلة كثيرة فيما يتعلق بقضية الخطاب بالواحد والاثنين والفرد، وكل واحد له عكسه، أي: مخاطبة الجمع والمراد التثنية، ومخاطبة التثنية والمراد الجمع.. كلها لها أمثلة وموجودة في هذا الكتاب وفي غيره.
وعلى العموم فهناك كثير من أنواع الخطابات التي ذكرها مثل: خطاب الجمادات، خطاب من يعقل ![]() فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ
فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ![]() [فصلت:11]، ومعلوم أن (طائعين) جمع مذكر، أي: خطاب الجمع جاء لما يعقل والمخاطب لا يعقل، وهذا كثير في القرآن، كأنها نُزّلت منزلة من يعقل، وهكذا كان جواب أبي عبيدة معمر بن المثنى ومن جاء بعده، مثل قوله:
[فصلت:11]، ومعلوم أن (طائعين) جمع مذكر، أي: خطاب الجمع جاء لما يعقل والمخاطب لا يعقل، وهذا كثير في القرآن، كأنها نُزّلت منزلة من يعقل، وهكذا كان جواب أبي عبيدة معمر بن المثنى ومن جاء بعده، مثل قوله: ![]() إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ
إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ![]() [يوسف:4] مع أنه لو أعاد إلى الشمس والقمر والكواكب لقال: ساجدة؛ لأنها لا تعقل، وهنا لقال: طائعة؛ لأنها لا تعقل، لكنه عاملها معاملة من يعقل.
[يوسف:4] مع أنه لو أعاد إلى الشمس والقمر والكواكب لقال: ساجدة؛ لأنها لا تعقل، وهنا لقال: طائعة؛ لأنها لا تعقل، لكنه عاملها معاملة من يعقل.
ثم ذكر فائدة وهي من لطائف الفوائد: قال بعضهم: خطاب القرآن ثلاثة أقسام:
قسم لا يصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. مثلما ذكرنا في قوله: ![]() يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ![]() [الأحزاب:50].
[الأحزاب:50].
وقسم لا يصلح إلا لغيره.
وقسم لهما. أي: يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلح لغيره.
ما ذكر من وجوه علوم القرآن
ثم ذكر فائدة عن ابن القيم طويلة مأخوذة من كتاب الفوائد، ثم انتقل بعد ذلك إلى فائدة ختم بها هذا الباب وقال عن بعض الأقدمين، وكم تمنيت لو أشار إلى من هو؛ لأن هذه الفائدة مهمة جداً، لأن هذا العالم الذي ذكر قوله قد ذكر جملة من علوم القرآن ولا بأس أن نذكرها: قال: أنزل القرآن على ثلاثين نحواً، كل نحو منه غير صاحبه، فمن عرف وجوهها ثم تكلم في الدين أصاب ووفق، ومن لم يعرفها فتكلم في الدين كان الخطأ إليه أقرب، وهي: المكي والمدني، والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والتقديم والتأخير، والمقطوع والموصول، والسبب والإضمار، والخاص والعام، والأمر والنهي، والوعد والوعيد، والحدود والأحكام، والخبر والاستفهام، والأبهة والحروف المصرفة، والإعذار والإنذار، والحجة والاحتجاج، والمواعظ والأمثال، والقسم.
هذه جملة من علوم القرآن وموضوعاته، ثم ذكر لهذا أمثلة، فذكر لكل واحدة من هذه أمثلة فنأخذ بعض الأمثلة وليس كل هذه الأمثلة؛ لكي لا يطول بنا المقام.
مثلاً قضية المحكم والمتشابه جعل المحكم ما له وجه والمتشابه ما يكون له أكثر من وجه.
التقديم والتأخير ذكر له مثالاً، المقطوع والموصول ذكره في مثل: ![]() لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ![]() [القيامة:1]، قال: فـ(لا) مقطوع من أقسم وإنما هو في المعنى "أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة"، ولم يقسم.
[القيامة:1]، قال: فـ(لا) مقطوع من أقسم وإنما هو في المعنى "أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة"، ولم يقسم.
هذا على قول فيه ضعف، لكنه مثال، وكما قيل: ليس من عادة الفحل الاعتراض على المثل، أي: المثال لا يعترض عليه، بمعنى: هل في القرآن مقطوع وموصول أو ليس في القرآن مقطوع وموصول؟ نعم، في القرآن مقطوع وموصول، لكن هذا المثال لا يصلح للمقطوع والموصول، وأمثلة المقطوع والموصول كثيرة.
طبعاً نلاحظ أن المقطوع والموصول الذي يتكلم عنه المؤلف هنا ليس المقطوع والموصول المتعلق بالرسم، وإنما المقطوع والموصول المتعلق بالمعنى.
وهو أقسام وسبق الإشارة إليه.
فذكر للسبب والإضمار مثالاً في قوله: ![]() وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ![]() [يوسف:82] أي: أهل القرية.
[يوسف:82] أي: أهل القرية.
والخاص والعام سبق قبل قليل، والأمر معروف.
والأبهة: قال: مثل: ![]() إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا
إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا ![]() [نوح:1] أو ما نسميها بالتعظيم، فالأبهة هي المعروفة عندنا بالتعظيم، وهي نون التعظيم في مثل:
[نوح:1] أو ما نسميها بالتعظيم، فالأبهة هي المعروفة عندنا بالتعظيم، وهي نون التعظيم في مثل: ![]() نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ![]() [الزخرف:32]، عبّر بالصيغة الموضوعة للجماعة عن الواحد تعالى تفخيماً وتعظيماً وأبهة.
[الزخرف:32]، عبّر بالصيغة الموضوعة للجماعة عن الواحد تعالى تفخيماً وتعظيماً وأبهة.
والحروف المصرفة: كالفتنة تطلق على الشرك في قوله: ![]() حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ
حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ![]() [البقرة:193]، وعلى المعذرة: نحو:
[البقرة:193]، وعلى المعذرة: نحو: ![]() ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ
ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ ![]() [الأنعام:23]، وعلى الاختبار: نحو:
[الأنعام:23]، وعلى الاختبار: نحو: ![]() قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ
قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ![]() [طه:85].
[طه:85].
فهذه ثلاثة معان للفتنة، وما المراد بها علم الوجوه والنظائر، والذي استخدم هذا التعبير المصرّفة أو التصاريف، هو يحيى بن سلام في كتابه التصاريف، فاستخدم عبارة التصاريف، فهل هذا العالم الذي ذكره هو يحيى ؟ قد يكون هذا محتمل، لكن أين قاله إن كان هو؟ الله أعلم. ومقدمة كتابه الذي هو التفسير كما هو موجود من اختصار ابن أبي زمنين أو هود بن محكم فيها إشارة إلى بعض هذه الأنواع التي ذكرها.
والإعذار كنوع مستقل وهو آخر نوع ذكره، وهو الإعذار والإنذار: نحو: ![]() فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ![]() [النساء:155] اعتذر أنه لم يفعل ذلك إلا بمعصيتهم.
[النساء:155] اعتذر أنه لم يفعل ذلك إلا بمعصيتهم.
ثم قال: والبواقي أمثلتها واضحة.
هذا ما يتعلق بقضية الخطابات، وأقول: إن هذا الموضوع لو أخذه أحد ورتب عليه رسائل علمية فإنه ممكن لهذه الرسائل بإذن الله، خصوصاً أنه موضوع طويل جداً، ويمكن تقسيمه إلى أفكار متعددة.
مدى تداخل أنواع العموم في بعضها
فإن قيل: هل تتداخل أنواع العموم في بعضها؟
فيقال: قد يختلف النظر فيها، لكن لا تتداخل، بمعنى: أنني قد أختلف أنا وأنت هل هذا من العام المخصوص أو من العام الذي هو على عمومه، أما أن تتداخل فلا.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
 البث المباشر
البث المباشر
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر
 الأكثر استماعا لهذا الشهر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
-
184763
تكبيرات العيد وتلبية الحجيج
(...) -
82567
البوم روائع القصائد
عبد الواحد المغربي -
32857
قصص الأنبياء - قصة ابراهيم في فلسطين وبناء الكعبة - قصة اسماعيل واسحاق- قصة قوم لوط
طارق السويدان -
31130
أذان بصوت الشيخ ناصر القطامي
ناصر القطامي -
22429
الدرس الأول
سمير مصطفى فرج -
21317
أذان محمد الدمرداش - جامع الملك فهد بحائل
محمد الدمرداش -
10095
سورة البقرة
مشاري راشد العفاسي -
7008
سورة البقرة
ماهر حمد المعيقلي

عدد مرات الاستماع
3090444862

 القرآن الكريم
القرآن الكريم علماء ودعاة
علماء ودعاة القراءات العشر
القراءات العشر الشجرة العلمية
الشجرة العلمية البث المباشر
البث المباشر شارك بملفاتك
شارك بملفاتك